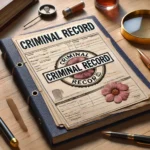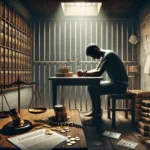تواصل معنا
محتوى المقال
أولا – طرق وضع الدستور :
إن الدستور يتم وضعه بصفة عامة من أجل تنظيم السلطات العامة في الدولة، وتحديد وضبط العلاقات التي تبين علاقة مؤسسات الدولة ببعضها البعض، وتحديد حقوق الأفراد والجماعات وحرياتهم والتزاماتهم تجاه الدولة، والدستور كوثيقة مكتوبة يتم وضعه في حالات متعددة من الصعب ضبطها وعلى العموم فهو يوضع عندما تحصل المستعمرات على استقلالها، أو عندما يحصل تغيير في النظام السياسي بفعل ثورة أو انقلاب، أو عندما يريد الحكام البحث عن قاعدة لمشروعية حكمهم، أو عندما يسفر تطبيق الدستور عن فشل، أو عندما تتحد مجموعة من الدول في إطار دولة اتحادية فتضع لأول مرة دستور ينظم حكم المؤسسات الفيدرالية .
إن طريقة وضع الدستور قد تختلف من دولة لأخرى، كما قد تختلف في إطار نفس الدولة باختلاف الظروف السياسية وتتأثر طريقة وضع الدستور بنظام الحكم في الدولة ، فإذا كان هذا النظام ديمقراطيا، اتبع في وضع الدستور أسلوبا ديمقراطيا، وإذا كان غير ذلك اتبع أسلوبا غير ديمقراطي.
وتسمى السلطة التي تتولى وضع الدستور أول مرة بالسلطة التأسيسية الأصلية، أما السلطة التي تتولى تعديله ومراجعته بعد دخول أحكامه ومقتضياته حيز التطبيق، فتسمى بالسلطة التأسيسية الفرعية.
ويتعلق البحث في طرق وضع الدساتير بالدساتير المكتوبة فقط التي تأخذ شكل وثيقة دستورية معينة، ولا ينصرف البحث مطلقا إلى الدساتير العرفية التي لا يتصور الاتفاق على طريقة معينة لوضعها، لأن منشأها العرف الذي ينشئها قاعدة في أوقات مختلفة وفي ظروف متغايرة، ويعترف بها كقواعد دستورية ملزمة وإن لم تثبت في وثيقة مكتوبة
هل تحتاج لمساعدة قانونية؟
فريقنا من المستشارين القانونيين والمحكمين جاهز لمساعدتك في جميع القضايا القانونية بخبرة ومهنية عالية
1 – الطرق غير الديمقراطية :
في إطار هذه الوسائل إما أن تكون الوثيقة الدستورية المراد اعدادها عبارة عن “منحة “من الحاكم إلى الشعب ، وإما أن يوضع الدستور في صورة عقد يربط الحاكم بالشعب.
أ – الدستور الممنوح :
يقصد بالمنحة كأسلوب لوضع الوثيقة الدستورية، وهو حينما يتم انشاء الدستور بإرادة الحاكم، أي ينفرد الحاكم بوضع الدستور دون مشاركة أو مساهمة من جانب الشعب ، فبمقتضى هذه الطريقة يكون هناك انعدام تام لأية مشاركة شعبية في وضع الدستور الممنوح، وفي هذه الحالة ينشأ الدستور كهبة أو منحة من الحاكم لشعبه، يحدد فيه سلطات الدولة واختصاصاتها، وما يتمتع به الأفراد من حقوق عامة وحريات فردية.
ويعد الدستور الذي يوضع عن طريق المنحة، كآلية انتقالية، من مرحلة الحكم الملكي المطلق إلى مرحلة الحكم الملكي المقيد، بمقتضاه يتنازل الحاكم عن جزء من سيادته وسلطاته المطلقة لصالح المحكومين (الشعب).
وقد يمنح الملك الدستور لشعبه بمحض إرادته واختياره، رغبة منه في تنظيم شؤون الدولة وتقربا منه لرعاياه من باب الحكمة وبعد النظر وقد يصدر الدستور تحت ضغط وإلحاح من جانب الشعب يخشى الملك معه الثورة أو الانفجار.
ومن أمثلة الدساتير التي وضعت بأسلوب المنحة، نذكر دستور فرنسا لسنة 1814 ، ودستور مصر لسنة 1923 ، ودستور قطر لسنة 1972، كذلك بعض الأنظمة العربية كالنظام الأساسي للحكم بالمملكة العربية السعودية لسنة 1990 ، والذي جاء في ديباجته ما يلي :
“بعون الله تعالى، نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، بناءا على ما تقتضيه المصلحة العامة للوطن، ونظرا لتطور الدولة في مختلف المجالات، ورغبة منا في تحقيق الأهداف التي تسعى إليها، أمرنا بما هو آت : أولا إصدار النظام الأساسي للحكم بالصيغة المرفقة بهذا. ثانيا يستمر العمل بكل الأنظمة والأوامر والقرارات المعمول بها عند نفاذ هذا النظام حتى تعدل بما يتفق معه. ثالثا ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره”.
ونتيجة هذا فإن الحكام كانوا شديد الحرص على ضمان ما يفيد معنى الدستور الممنوح من عبارات وجمل توثق في ديباجة الدساتير.
والفقه الدستوري اختلف حول قيمة الدستور الممنوح ومدى سلطات المالك في ما منحه او التخلي عنه، فبعض الآراء تعطي لمن يمنح الدستور حق استرجاعه طبقا لقاعدة أن من يعطي يملك ان يتراجع عما منحه ، لكن أقلية قليلة من الفقهاء هي التي تعتمد هذا الرأي أما غالبية الفقهاء فتذهب إلى أنه ليس من حق الملوك والحكام سحب الدساتير التي منحوها، لأن منح تلك الدساتير ترتبت عنه مجموعة من الحقوق لصالح أفراد الشعب، وأصبحت بمثابة حقوق مكتسبة لا يمكن إعدامها، وكل مساس بها من شأنه أن يؤدي إلى قيام الثورة من أجل الدفاع عن تلك الحقوق، وتعليل ذلك هو أن الحاكم حينما يمنح الدستور ويتنازل بإرادته عن بعض سلطاته يكون قد التزم قانونا بما منحه.
وفضلا عن ذلك فإن المنحة تعد التزاما بإرادة منفردة، والقاعدة المقررة في هذا الصدد أن الالتزام بالإرادة المنفردة يقيد شخص الملتزم وبالتالي لا يجوز له الرجوع فيه.
وقد انتقدت هذه الطريقة بكونها تعد دليلا على عدم تقدم الروح الديمقراطية، كما أنها تجرح كرامة المواطن، ولهذا فهي تعد طريقة غير ديمقراطية لا يمكن أن توجد إلا في ظل نظام غير ديمقراطي، وهي أسلوب في طريقه إلى الزوال بصفة نهائية.
ب – الدستور التعاقدي :
وتسمى أيضا بطريقة الاتفاق، وفيها يكون الدستور ناتجا عن تعاقد بين الحاكم وشعبه، فتتلاقى إرادة الطرفين في وضع مجموعة من القواعد الدستورية يقبل كل منها الخضوع لها، وتعد هذه الطريقة أكثر ديمقراطية من طريقة المنحة، لأن بمقتضاها تظهر إرادة الشعب إلى جانب إرادة الحاكم، فالدستور يوضع بشراكة بين الحاكم والشعب وكنتيجة لذلك فأحكام الدستور تلزم الحاكم كما تلزم أفراد الشعب، ولا يحق للحاكم الخروج عنها أو تعديلها بإرادته المنفردة بل لابد له من موافقة الشعب الذي يعتبر طرفا في العقد لا يمكن تجاوزه.
وغذا كان أسلوب العقد في وضع الدساتير من المزايا الإيجابية باعتباره جسرا تنتقل من خلاله الأمة من مرحلة السكون الى مرحلة المشاركة واتخاذ القرار في قانونها الأساسي وتقرير ماتراه مناسبا ومتلائم مع اتجاه الحاكم، وبالتالي خطوة هامة من خطوات التطور الديمقراطي وان أهم ما يوجه لهذا الأسلوب في وضع الدساتير من نقد هو أن الحاكم وحده كفرد عندما يشارك الأمة في وضع الدستور وإصداره فإنه يتساوى مع هذه الأمة بكل ما تحتويه من أفراد وهذا الأسلوب يتنافى مع الديمقراطية وحقيقتها .
ومن أمثلة الدساتير التي صدرت في صورة عقد تذكر دستور فرنسا لسنة 1830، ودستور الأردن لسنة 1952، ودستور الكويت الصادر سنة 1962، ودستور دولة البحرين لسنة 1973.
وعلى الرغم من كون طريقة العقد، تعد خطوة أساسية في طريق الديمقراطية، وعلى الرغم من كونها تفضل بكثير طريقة المنحة، إلا أنها تعد مع ذلك طريقة غير ديمقراطية، لكون الملك (الحاكم) ، يعد في هذه الحالة مساويا للأمة (الشعب) ، مع أنه لا يقتسم معها حق السيادة فالسيادة هي ملك للشعب وحده، ولا يتقاسمها مع الحكام، ويعتبر هذا الأمر من أهم الشروط التي تقوم عليها الديمقراطية، وترتكز عليها دولة الحق والقانون.
2 – الطرق الديمقراطية :
على خلاف الطرق غير الديمقراطية، فإن الطرق الديمقراطية في وضع الدساتير ترتكز أساسا على دور الشعب في وضع الدستور، فالشعب هو صاحب السيادة وإليه توكل السلطة التأسيسية الأصلية التي تعد أعلى السلطات في الدولة، وتبعا لذلك فالدستور يوضع بواسطة أفراد الشعب.
وحينما يتم الأخذ بهذا الأسلوب الديمقراطي في وضع الوثيقة الدستورية، يؤدي الى انتصار إرادة الشعوب وانتقال السيادة من الحاكم إلى الشعب، حيث تكون الوثيقة الدستورية من عمل الأمة ذاتها ووحدها، ويمكن أن نميز بين أسلوبين وهما: أسلوب الجمعية التأسيسية. وأسلوب الاستفتاء الدستوري.
أ – وضع الدستور عن طريق الجمعية التأسيسية :
بواسطة هذه الطريقة، يقوم الشعب بانتخاب هيئة نيابية يناط بها مهمة وضع الدستور، وتسمى هذه الهيئة النيابية بالجمعية التأسيسية أو المجلس التأسيسي، وتبعا لهذه الطريقة يصدر الدستور ويصير نافذا بمجرد إقراره من جانب الجمعية التأسيسية، دون أن يتوقف ذلك على موافقة أحد.
وتعتبر طريقة الجمعية التأسيسية من نتائج إعمال نظرية السيادة الشعبية التي ترجع أصل كل السلط إلى الشعب صاحب السيادة . فالشعب يدعى إلى انتخاب جمعية تأسيسية تنوب عنه وتنحصر مهمتها فقط في وضع الدستور الذي يصبح نافذا وساري المفعول بمجرد وضعه دون حاجة إلى عرضه على المصادقة الشعبية من جديد.
وتعد هذه الطريقة أكثر ديمقراطية من غيرها من طرق المنحة والعقد، حيث يعد الشعب هو وحده المهيمن على وضع الوثيقة الدستورية.
ومن أمثلة الدساتير التي وضعت عن طريق الجمعية التأسيسية الدستور الفيدرالي للولايات المتحدة الأمريكية الصادر سنة 1787 ، ودستور البرتغال لسنة 1976 ، ودستور تونس لسنة 2014.
ب – وضع الدستور عن طريق الاستفتاء الدستوري :
تعتبر طريقة اللجوء الى الاستفتاء الشعبي في وضع الدساتير التطبيق الحقيقي للديمقراطية المباشرة حيث من خلاله يباشر الشعب بنفسه سلطاته دون مشاركة أحد ويفهم من الاستفتاء اصطلاحا “إبداء الرأي بشأن قضية أو موضوع معين قد يكون دستوريا أو سياسيا أو اجتماعيا أو حتى خاصا بالأمور المرتبطة بالعلاقات الخارجية “.
تبعا لطريقة الاستفتاء الدستوري، يتم وضع مشروع الدستور عن طريق جمعية نيابية أو لجنة فنية تقوم بمجرد تحضيره وإعداده، ثم يعرض هذا المشروع على الشعب لاستفتائه فيه .ولا يأخذ الدستور قوته الملزمة بطبيعة الحال إلا بعد موافقة الشعب عليه وإقراره له في الاستفتاء، فإذا تم ذلك صار الدستور نافذا دون حاجة إلى عرضه على الحاكم بعد ذلك للموافقة عليه.
وتتميز طريقة الاستفتاء الدستوري عن طريقة الجمعية التأسيسية، في كون هذه الأخيرة تجعل أمر المصادقة النهائية على الدستور بيد الجمعية النيابية التي ينتخبها الشعب، ويصبح الدستور نافذا بمجرد إصداره من طرفها.
أما في طريقة الاستفتاء الدستوري فإن أمر المصادقة النهائية على الدستور يرجع إلى الشعب وحده دون غيره مهما كانت الجهة التي قامت بإعداد وتحضير مشروع الدستور.
ومن أمثلة الدساتير التي وضعت عن طريق الاستفتاء الدستوري، دستور فرنسا لسنة 1958 ودستور الجزائر لسنة 1989 ، ودستور إسبانيا لسنة 1978.
وطبقا لهذا الأسلوب أيضا صدرت جميع دساتير المملكة المغربية ابتداءا بدستور سنة 1962 وانتهاء بدستور سنة 2011 ، ويؤكد أغلبية الفقه على ديمقراطية هذه الطريقة التي تعتمد على موافقة الشعب ، فهي أصدق الطرق والأساليب تعبيرا عن الرأي الحقيقي للأمة، مما جعل الاتجاه الدستوري الغالب في الوقت الحاضر يفضل الأخذ بها، كطريقة تفضل غيرها من الطرق في وضع الوثيقة الدستورية.
ولكن على الرغم من أفضلية هذه الطريقة على الطرق الأخرى، فإن نجاحها يبقى مرهونا بمدى ارتفاع درجة وعي الشعب الذي يرجع إليه أمر الموافقة على مشروع الدستور المعروض عليه أو رفضه، كما يبقى مرهونا بمدى توفر الإرادة السياسية الحقيقية والكاملة الهادفة إلى تحقيق الديمقراطية.
وجدير بالذكر أن رجال الفقه الفرنسي لا يرحبون بالاستفتاء الشعبي، الذي يطلق عليه الاستفتاء السياسي، تمييزا له عن الاستفتاء الدستوري، حيث يرون أن الأول (الشعبي أو السياسي) يستعمل كواجهة فقط لإخفاء حقيقة النظام الدكتاتوري، وإضفاء الشرعية عليه عن طريق استطلاع رأي الشعب دون أن يكون لهذا الأخير أي دور حقيقي في إقرار الدستور نظرا لكون الشعب في غالب الحالات يقبل ما يعرض عليه في ظروف يتعذر عليه أن يفعل خلاف ذلك ، كما أن هذا النوع من الاستفتاء أي السياسي غالبا ما يكون مقرونا بنسبة تزوير كبيرة لإرادة الشعوب.
و اعتمادا على هذا التفريق والتمييز بين الاستفتاء الدستوري (الذي يعد ديمقراطيا) والاستفتاء الشعبي الذي غالبا ما يكون مجرد واجهة فقط تخفي الكثير من الحقائق ، يمكن القول بأن أغلبية دساتير دول العالم الثالث التي تأخذ بطريقة الاستفتاء في وضع دساتيرها، تندرج في إطار الاستفتاء السياسي، لهذا غالبا ما يتم إقرار الدستور بنسبة تصويت خيالية قد تصل إلى نسبة %99.99% من المصوتين لصالح الدستور.
وتبقى طريقة الاستفتاء الدستوري أفضل طريقة ديمقراطية لوضع دستور ديمقراطي، وتعد من أهم ركائز ودعائم دولة الحق والقانون.
ثانيا – تعديل الدستور :
إذا كان من غير المتصور أن تتعرض الوثائق الدستورية للتغيير اليومي، نظرا لأنها وضعت لكي تستمر، فإن تعديلها يبقى واردا إما لتلافي الثغرات التي أسفر عنها تطبيقها وإما لتكييفها حسب تطور المعطيات الاقتصادية والسياسية للبلاد. وعملية تعديل الدستور ومراجعة أحكامه ترتبط أساسا بالدساتير الجامدة التي تتطلب ضرورة اتباع إجراءات خاصة في تعديل أحكامها، على خلاف الدساتير المرنة التي لا تتطلب أية إجراءات خاصة في ذلك.
1 – سلطة التعديل وحدودها :
إن الجهة المختصة بتعديل الدستور لا تتمتع بسلطات مطلقة في عملها، بقدر ما يجب أن تتقيد بمجموعة من الحدود والقيود الواردة في الدستور ذاته. وتختلف هذه السلطة المختصة بالتعديل من دستور لآخر ومن دولة لأخرى.
أ – سلطة التعديل :
قبل عرض السلطة المختصة بتعديل الدستور حسب الدساتير يجدر بنا أولا أن نذكر بالتمييز القائم بين السلطة التأسيسية الأصلية والسلطة التأسيسية الفرعية، فالأولى هي المختصة بوضع الدستور لأول مرة، أما الثانية (أي الفرعية) فهي التي تتولى فقط تعديل مقتضيات الدستور الموجود طبقا للإجراءات والشروط المنصوص عليها فيه.
و الجهات التي تباشر السلطة التأسيسية الفرعية المنشأة تختلف باختلاف الدساتير، لأن واضعي الدستور عادة ما يخولون صلاحية تعديله للسلطة التي يريدون إعطاءها مكانة سامية في الدولة ، وتدل قراءة دساتير العالم على تنوع سلطة التعديل بتنوعها ، فمن الدساتير من أسند مهمة اقتراح التعديل للسلطة التنفيذية، ومنها من أسند اقتراح تعديل الدستور للسلطة التشريعية، ومنها من اتخذت موقفا وسطا فجعلت حق الاقتراح عملية مشتركة بين الجهازين التشريعي والتنفيذي معا، ومنها من أعطت حق الاقتراح إلى جمعية تأسيسية، ومنها من سمحت للشعب بأن يطلب اقتراح تعديل الوثيقة الدستورية بجانب السلطات العامة، ولهذا فإن جهاز المراجعة المكلف بتعديل الدستور ليس متماثلا في جميع الأنظمة الدستورية.
وبخصوص سلطة التعديل في المغرب، ليس هناك تطابق بين مختلف الدساتير التي عرفتها المملكة المغربية حول الجهة المخول لها اقتراح تعديل الدستور، فدستور 1962 كان يخول هذه السلطة للوزير الأول ولأعضاء البرلمان، وأما دستور 1970 كان يخولها للملك فقط، غير أن دستور 1972 خول هذه السلطة للملك ولمجلس النواب، وهو نفس الأمر الذي نص عليه دستور 1992 ، غير أن دستور 1996 فقد جعل حق اتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستور بيد كل من الملك ومجلس النواب ومجلس المستشارين، واحتفظ نص دستور 2011 في هذا الخصوص على ما جاء في دستور 1996 حيث نص أن ” للملك ولرئيس الحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين حق اتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستور”.
وعموما فالسلطة المخول لها حق اقتراح مراجعة وتعديل الدساتير تختلف باختلاف هذه الأخيرة، كما تختلف مسطرة المصادقة على هذه الاقتراحات
ب – حدود سلطة التعديل :
إن سلطات الجهات المختصة بتعديل الدساتير ومراجعة أحكامها، ليست سلطات مطلقة، وإنما هي سلطات مقيدة ومحدودة بمجموعة من الضوابط والمقتضيات التي لا يجوز لها بتاتا، ومهما كانت الظروف والأسباب المس بها أو تعديل محتوياتها أو إلغائها.
فالمشرع الدستوري أي السلطة التأسيسية الأصلية غالبا ما تقيد صلاحيات وسلطات السلطة التأسيسية الفرعية المكلفة بتعديل الدستور حيث ينص على حظر ومنع تعديل بعض مقتضيات الدستور وهذا الحظر قد يكون ظرفيا ، وقد يكون موضوعيا.
يقصد من الحظر الزمني هو حماية الدستور فترة من الزمن لا يجوز خلالها اقتراح تعديل أحكامه، بهدف ضمان نفاذ قواعده فترة تكفي لتثبيتها وترسيخها، قبل أن يسمح باقتراح تعديلها، ومن أمثلة الدساتير التي حظرت تعديلها إلا بعدد مرور فترة زمنية معينة، الدستور الفرنسي لسنة 1795 الذي كان يمنع تعديله قبل مرور خمس سنوات.
و دستور البحرين لسنة 1973 الذي يمنع منعا كليا اقتراح تعديله قبل مضي خمس سنوات على العمل به، ورغم كون هذا الحظر يعد حظرا شموليا لكل تعديل يمس مقتضيات الدستور فهو مع ذلك يبقى حظرا مؤقتا لأنه يشمل مدة زمنية محددة، يجوز بعد مرورها اقتراح تعديله.
وفي إطار الحظر الزمني توجد مجموعة من الدساتير تمنع تعديل مقتضياتها في فترات معينة، كدستوري فرنسا لسنتي 1946 و 1958 ، اللذان يمنعان إجراء أي تعديل لمقتضيات الدستور أثناء احتلال كل أو بعض أراضي فرنسا من طرف قوات أجنبية.
يهدف المشرع الدستوري من النص على منع تعديل مجموعة من مقتضيات الدستور (الحظر الموضوعي) إلى حماية الدعائم الأساسية التي يقوم عليها النظام السياسي أو بعض نواحي ذلك النظام، والرغبة في ضمان بقاء هذه الدعائم دون تعديل أو تبديل، كما يهدف المشرع الدستوري من ذلك إلى عدم تعرض فلسفة النظام السياسي ومذهبه الإيديولوجي للتعديل .
فالحظر الموضوعي، يهدف إلى حماية أحكام ومقتضيات معينة في الدستور، وذلك بمنع تعديلها، نظرا لكونها تشكل إما ثابتا من ثوابت الدولة، أو أحد الدعامات الأساسية التي يقوم عليها النظام السياسي في الدولة.
ومن أمثلة الدساتير التي تحظر وتمنع بصفة كلية ومطلقة، تعديل مجموعة من مقتضياتها وأحكامها الدساتير الفرنسية ابتداء من دستور 1848 وانتهاء بدستور 1958 ، والتي تحظر تعديل النصوص المتعلقة بالشكل الجمهوري للحكومة، وكذلك دساتير المملكة المغربية بدءا بدستور 1962 ووصولا إلى دستور 2011 ، والتي تمنع تناول النظام الملكي للدولة وكذلك النصوص المتعلقة بالدين الإسلامي بالتعديل والمراجعة.
ومن مستجدات دستور 2011 في هذا الخصوص توسيع المجالات الممنوع مراجعتها، وفي هذا الصدد ينص الفصل 175 على أنه “لا يمكن أن تتناول المراجعة الأحكام المتعلقة بالدين الإسلامي وبالنظام الملكي للدولة، وبالاختيار الديمقراطي للأمة، وبالمكتسبات في مجال الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور”.
وخلاصة القول هو أن اختصاصات وصلاحيات السلطة التأسيسية الفرعية مقيدة بمجموعة من الشروط والقيود المحددة في الدستور، والتي تمنعها إما من إجراء أي تعديل على الدستور برمته لفترة زمنية محددة، وإما من إجراء أي تعديل على مجموعة من المقتضيات والأحكام الواردة في الدستور والتي تشكل جوهر وصلب النظام السياسي في الدولة، وأساس فلسفته وأيديولوجيته.
2 – مسطرة التعديل :
إذا كان هناك اختلاف بين الدساتير حول الجهة المختصة بتعديل الدستور، فإن نفس الأمر أي الاختلاف يوجد بين الدساتير حول المسطرة المنصوص عليها لإقرار التعديل، ولكن على الرغم من ذلك، فإن المشرع الدستوري في كل الدول ذات الدساتير الجامدة يحاول دائما التوفيق بين اعتبارين أساسيين فيما يخص مسطرة التعديل وهي:
– الأولى وهي ألا تكون مسطرة التعديل جد مبسطة ومن شأنها تعريض النظام لعدم الاستقرار الدستوري، بل وتحويل الدستور الصلب إلى دستور مرن عمليا.
– الثانية وهي ألا تكون مسطرة التعديل جد معقدة، حتى لا تؤدي استحالة تعديل الدستور بواسطتها وقد يؤدي إلى الانقلاب على نظامه.
وكنتيجة لذلك، فإن بعض الدساتير تنص على تعديلها باتباع مسطرة الاستفتاء، كدستور سويسرا مثلا، ودستور فرنسا … فيما تشترط دساتير أخرى ضرورة توفر أغلبية برلمانية محددة لتعديلها ( كدستور الولايات المتحدة الأمريكية مثلا) الذي يشترط موافقة ثلثي أعضاء الكونغرس وثلاث أرباع الولايات على تعديل الدستور الأمريكي، والدستور الفرنسي الذي ينص على إمكانية اجتماع مجلسي البرلمان في مؤتمر للتصويت بأغلبية ثلاثة أخماسه على مشروع تعديل قدمه رئيس الجمهورية باقتراح من الوزير الأول…
أما في المغرب، فإن المسطرة المعمول بها لمراجعة الدستور وتعديل أحكامه، هي مسطرة الاستفتاء، وهذه المسطرة تم النص عليها في جميع الدساتير التي عرفتها المملكة المغربية بالرغم من كون كل الدساتير التي عرفها المغرب تشترط ضرورة الموافقة على مراجعة الدستور عن طريق الاستفتاء، فإنها اختلفت فيما بينها حول الجهة التي لها الحق في اقتراح المراجعة وطرحها .
فدستور 1962 كان ينص فيما يخص مراجعة الدستور على أن التقدم بطلب مراجعة الدستور حق يتمتع به الوزير الأول والبرلمان (الفصل 104)، وأن مشروع المراجعة يضعه المجلس الوزاري ويجب أن يكون محل مداولة من طرف المجلسين (الفصل 105 ) وبأن اقتراح المراجعة يجب أن يتخذه كل مجلس بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم المجلس” (الفصل 106) ، وعلى أن تصير المراجعة نهائية بعد الموافقة عليها بالاستفتاء ( الفصل 107 ).
أما دستور 1970 فكان ينص في (المادة 97) منه على أن “للملك حق اتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستور”، وكان ينص في (المادة 98) على أنه “يمكن لمجلس النواب أن يقترح على الملك مراجعة الدستور إذا تم اتفاق ثلثي أعضائه على تقديم هذا الاقتراح”، وكانت (المادة 99) تنص “على أن تصير المراجعة نهائية بعد إقرارها بالاستفتاء.”
أما دستور 1972 فقد حول حق اقتراح تعديل الدستور للملك ولمجلس النواب (الفصل 98 )، واشترط ضرورة موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب على الاقتراح الذي يتقدم به أحد أعضاء المجلس (الفصل (99) ، وفي جميع الحالات وسواء إذا كان الاقتراح بمبادرة ملكية أو بمبادرة من مجلس النواب.
وبالنسبة لدستور 1996 نجده كان يخصص الباب الثاني عشر منه لمراجعة الدستور، وينص في (الفصل 103) على أن “للملك ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين حق اتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستور”، وللملك أن يستفتي شعبه مباشرة في شأن المشروع الذي يستهدف به مراجعة الدستور” .
وينص (الفصل 104) على أن” اقتراح مراجعة الدستور الذي يتقدم به عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النواب أو مجلس المستشارين لا تصح الموافقة عليه إلا بتصويت ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس المعروض عليه الاقتراح، ويحال الاقتراح بعد ذلك إلى المجلس الآخر، ولا تصح الموافقة عليه إلا بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم.”أما دستور 2011 ، فقد نص من خلاله المشرع الدستوري على أن “للملك أن يعرض مباشرة عن الاستفتاء المشروع الذي اتخذ المبادرة بشأنه “.
ونص (الفصل 173) من دستور 2011 على أنه “لا تصح الموافقة على مقترح مراجعة الدستور الذي يتقدم به عضو أو أكثر من أعضاء أحد مجلسي البرلمان، إلا بتصويت أغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، ويحال هذا المقترح إلى المجلس الآخر، الذي يوافق عليه بنفس أغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم، ويعرض المقترح الذي يتقدم به رئيس الحكومة على المجلس الوزاري، بعد التداول بشأنه في مجلس الحكومة”.
وبخصوص مسطرة مراجعة الدستور، نص (الفصل 174) من دستور 2011 على أن “تعرض مشاريع ومقترحات مراجعة الدستور بمقتضى ظهير على الشعب قصد الاستفتاء تكون المراجعة نهائية بعد إقرارها بالاستفتاء”.
فإن مراجعة الدستور لا تصير نهائية إلا بعد موافقة الشعب عن طريق استفتاء عام (الفصل100) ونفس المقتضيات المنصوص عليها في دستور 1972 والخاصة بمراجعة الدستور هي التي تم الاحتفاظ بها في ظل (دستور 1992 الباب الحادي عشر الفصول 97 ، 98 ، 99) للملك، بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية، أن يعرض بظهير على البرلمان مشروع مراجعة بعض مقتضيات الدستور.
ويصادق البرلمان، المنعقد بدعوة من الملك، في اجتماع مشترك لمجلسيه، على مشروع هذه المراجعة، بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم، ويحدد النظام الداخلي لمجلس النواب كيفيات تطبيق هذا المقتضى، وتراقب المحكمة الدستورية صحة إجراءات هذه المراجعة وتعلن نتيجتها.
ثالثا – أساليب نهاية الدستور :
حينما يتم انتهاء العمل بالدستور بمناسبة تعديله وإلغاء أحكامه بشكل شامل، إما رغبة في تجاوز عجز الدستور عن مسايرة ركب التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي، أو بمناسبة استبدال فلسفة الدولة السياسية بأخرى مغايرة لها بواسطة الإطاحة بالدستور عن طريق الثورة مثلا فالمقصود بنهاية الدستور، هو التعديل الكلي لأحكامه وليس مجرد تعديل بعض مقتضياته، وقد ينتهي العمل بالدستور بطريقتين.
1 – الأسلوب العادي لنهاية الدستور :
يقصد بالأسلوب العادي لإنهاء العمل بالدستور، إلغاء جميع أحكامه وتوقف العمل بها، بطريقة سلمية، وفي هدوء تام، واستبداله بدستور جديد يتضمن مقتضيات وأحكام جديدة تتلائم مع التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.
وانتهاء حياة الدستور بالإلغاء، يختلف بحسب ما إذا كان الدستور عرفيا أو مكتوبا، فإذا كان عرفيا فينتهي العمل به إما بواسطة دستور عرفي جديد، وإما بواسطة إصدار دستور مكتوب يحل محل الدستور العرفي، أما إذا كان الدستور مكتوبا فيجب أن نميز في إطاره بين الدساتير الجامدة والدساتير المرنة.
فالدساتير المرنة، لا تطرح أية صعوبة فيما يخص تعديلها بصفة كلية وشمولية، حيث لا تتطلب أية إجراءات خاصة في ذلك، ومن ثم يمكن للمشرع العادي أن يعدل الدستور برمته. أما الدساتير الجامدة، فلا يمكن تعديل مقتضياتها إلا بإجراءات خاصة، ولا تملك السلطة التي لها الحق في تعديل الدستور جزئيا السلطة التأسيسية الفرعية الحق في تعديله كليا.
وبالرجوع إلى مختلف الدساتير المكتوبة الجامدة، نجدها عادة ما تنص على كيفية تعديلها جزئيا،في حين لا تتضمن غالبا أية مقتضيات متعلقة بتعديلها بصفة كلية أو بالغائها، وعموما فقد اختلفت الدساتير في هذا الخصوص، فمنها من أجاز للسلطة التأسيسية الفرعية إمكانية تعديل الدستور تعديلا شاملا، كالدستور الفرنسي لسنة 1875 ، والدستور الإسباني لسنة 1978.
وإذا كانت السلطة القائمة على أمر التعديل لا تملك كأصل عام الإلغاء الكلي لنصوص الدستور، فإن السلطة التأسيسية الأصلية التي تمثل الشعب، وتعبر عن سيادة الأمة تملك إلغاء الوثيقة الدستورية برمتها وإحلال أخرى محلها، وقد يتم ذلك بنفس طرق وضع الدساتير (المنحة أو العقد أو الجمعية التأسيسية أو الاستفتاء الدستوري).
والإلغاء الكلي لأحكام الوثيقة الدستورية قد يكون ضمنيا، وذلك في حالة ما إذا كانت الفكرة التي يقوم عليها الدستور الجديد متناقضة مع تلك التي قام عليها الدستور القديم، أو في حالة ما إذا تناول الدستور الجديد جميع الموضوعات الواردة في الدستور الملغي، وقد يكون صريحا وذلك في حالة ما إذا تضمن الدستور الجديد فصلا ينص بشكل صريح على إلغاء الدستور السابق،
وكمثال على ذلك دستور المغرب لسنة 1972 الذي ينص في الفصل 103 منه على “أن يلغى الدستور الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 70-1-177 بتاريخ 27 جمادى الأولى 31 يوليوز 1970 ، فهذا الفصل ينص بشكل صريح على إلغاء كلي لمقتضيات دستور 1978، وقد يتم إنهاء العمل بالدستور نتيجة ذوبان الشخصية القانونية للدولة في إطار اتحاد فدرالي مثلا.
2 – الأسلوب غير العادي لنهاية الدستور :
تمثل الطرق غير العادية لإلغاء الدستور احدى الوسائل التي يتم اللجوء اليها لوضع حد للدستور القائم، ويبين لنا التاريخ أن كثير من الدساتير العالمية قد انتهت بأسلوب غير عادي عن طريق ثورة أو انقلاب.والثورة أو الانقلاب وسيلتان واقعيتان لنهاية الدساتير لا وسيلتين قانونيتين، لان الدساتير لا تنص عادة على أي من هاتين الوسيلتين كآلية مشروعة لوضع حد لسريانها، وذلك رغم أن الواقع يبرز دورها الأساسي في نهاية الدساتير في مختلف الأمكنة والفترات التاريخية،
ويفرق الفقه الدستوري بينهما في المفهوم والمعنى، فبعض الفقه يميز بين الثورة والانقلاب على أساس اختلاف الهيئة التي تقوم بالحركة الثورية، فالثورة يقوم بها الشعب في حين أن الانقلاب يقوم به بعض الأشخاص ينتمون للسلطة الحاكمة مثل رئيس الدولة، أو رئيس الحكومة، أو قائد الجيش.
و هذا الأسلوب يؤدي الى إنهاء العمل بالدساتير أو إلغائها عن طريق الثورة أو الانقلاب وبمعنى آخر انتهائها بالطريق الفعلي لا بالطريق القانوني، وتكون نهاية الدستور في هذا الإطار مرتبطة بنهاية النظام المرتبط به، وتشكل هذه الحالة السبب الأساسي لنهاية الدساتير ذلك أن الدستور كمجموعة قواعد للحكم والمشروعية المرتبطة بحياته ووجوده بالنظام السياسي الذي أقره، فإذا ما قضى على هذا النظام إثر ثورة أو انقلاب، فإن الملاحظ أن أول بلاغ للانقلابين أو الثوار يعلن عن إلغاء دستور النظام المطاح به.
وثمة فارق جوهري بين الثورة والانقلاب، فإذا كان هدف الحركة الثورية هو تغيير النظام السياسي أو تغيير النظام الاجتماعي، أو العمل على إعادة تنظيم العلاقات بين مختلف الطبقات الاجتماعية وذلك بتقليص الفوارق بين الطبقات فالحركة الثورية تعد ثورة، أما إذا كان هدف هذه الحركة هو الاستئثار والتفرد بالسلطة فإنها تعد انقلابا، كأن يعمد أحد رجال الحكم إلى إنهاء أو إلغاء الدستور أو تعديله من أجل تحقيق مصلحة خاصة،
وبعبارة أخرى، فإن الانقلاب يهدف تحقيق مصلحة فرد أو جماعة صغيرة، أما الثورة فتهدف إلى استبدال النظام السياسي أو الاجتماعي أو هما معا بأنظمة جديدة من شأنها تحقيق المصلحة العامة، إلا أن ما ينبغي عدم إغفاله هو أن الثورة والانقلاب يؤديان معا إلى إلغاء الدستور وإنهاء العمل به.
وإذا كانت الدساتير لا تنص عادة على هذا الأسلوب في انتهاء العمل بها، فإن هذا الأسلوب يلعب دورا رئيسيا في الحياة العملية، إذ انتهت معظم الدساتير في العديد من الدول بواسطة الأسلوب الثوري.
ومن أمثلة الدساتير التي انتهت بأسلوب الثورة، دستور مصر لسنة 1923 الذي ألغي بقيام ثورة 23 يوليوز 1952 ، ودستور ليبيا لسنة 1951 الذي ألغي بثورة الفاتح من شتنبر 1969 ، ومن الأمثلة الحديثة للدساتير التي ألغيت عن طريق الثورة، نذكر دستور مصر لسنة 1971 فبعد قيام ثورة 25 يناير 2011 ، وتنحي الرئيس السابق محمد حسني مبارك، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلانا دستوريا،
وبعد الانتخابات الرئاسية التي عرفتها مصر في سنة 2012 ، تم وضع دستور جديد في نفس السنة، وبتاريخ 30 يونيو 2013، قامت ثورة جديدة ضد حكم الرئيس محمد مرسي على إثرها عطل العمل بدستور 2012، وتم تشكيل لجنة الخمسين التي كلفت بإعداد مشروع دستور جديد، وقد عرض على الشعب المصري للاستفتاء يومي 14 و 15 يناير 2012.
و من بين الدساتير التي تم إنهاؤها عن طريق الثورة أيضا، دستور تونس لسنة 1959 الذي تم تعليق العمل به بعد ثورة 14 يناير 2011 وذلك بصدور المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، ثم تقرر إنهاء العمل به بمقتضى الفصل 27 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 دجنبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.
أما الدساتير التي انتهت بطريق الانقلاب، فتذكر منها، دستور الجزائر لسنة 1963 الذي الغي بانقلاب 19 أكتوبر 1965 ، والدستور الموريتاني لسنة 1964 الذي ألغي بانقلاب 1978 .
وتجدر الإشارة إلى أن إلغاء الدستور وإنهاء العمل بأحكامه سواء كان ذلك عن طريق الأسلوب العادي أو عن طريق الثورة أو الانقلاب، لا يترتب عنه إلغاء العمل بالقوانين العادية الجاري بها العمل، حيث تظل سارية المفعول ما لم تلغى صراحة، أو تكون متعارضة مع أحكام الدستور الجديد او مع شكل الحكومة الجديد، فتلغى ضمنيا، وبعد ذلك من أهم مظاهر مبدأ استمرارية وديمومة الدولة التي تبقى قائمة رغم اختلاف أنظمة الحكم المتعاقبة عليها، واختلاف الدساتير المعمول بها.
هل تحتاج لمساعدة قانونية؟
فريقنا من المستشارين القانونيين والمحكمين جاهز لمساعدتك في جميع القضايا القانونية بخبرة ومهنية عالية
مراجع :
رمزي طه الشاعر: النظرية العامة للقانون الدستوري.
د علي الحنودي: القانون الدستوري، النظرية العامة.
عبد الحميد متولي، القانون الدستوري والأنظمة السياسية.
شارك هذا المحتوى: