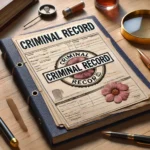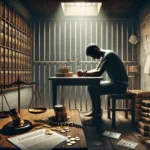تواصل معنا
أولا // التأليف البشري للمحاكم الابتدائية :
نصت المادة 42 من ظهير التنظيم القضائي علي أنه ” تتألف المحكمة الابتدائية من: رئيس ؛ وكيل الملك؛ نائب أو أكثر للرئيس وقضاة؛ نائب أول أو أكثر لوكيل الملك وباقي نوابه؛ رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة ورؤساء مصالح وموظفي كتابة الضبط وموظفي كتابة النيابة العامة”. وقد أوضح المشرع في هذه المادة تأليف المحكمة الابتدائية، حاصرا تشكيلها في:
– رئيس المحكمة الابتدائية : هو الشخص الذي يتولى رئاسة المحكمة ويشغل أعلى منصب فيها، ويقوم بإدارتها وتنظيم شؤونها. كما يرأس مجموعة من أجهزتها مثل مكتب المحكمة والجمعية العامة لها. وتعتبر رئاسة المحكمة الابتدائية من المهام القضائية ذات المسؤولية وفقًا للبند الأول من المادة 5 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، الذي يشترط أن يكون المرشح لهذا المنصب من القضاة المرتبين على الأقل في الدرجة الثانية، وذلك وفقًا للمادة 19.
– وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية : هو المسؤول عن رئاسة جهاز النيابة العامة في هذه المحكمة، ويعمل تحت إشرافه نائب أو عدد من النواب، وفقًا للمبادئ المنظمة لعمل النيابة العامة.
كما هو الحال في رئاسة المحكمة الابتدائية، فإن رئاسة النيابة العامة على مستوى المحكمة الابتدائية، التي يتولاها وكيل الملك، تعتبر من مهام المسؤولية القضائية وفقًا للبند الثاني من المادة 5 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. ويشترط في المرشح لهذا المنصب أن يكون من القضاة المرتبين على الأقل في الدرجة الثانية، وذلك وفقًا للمادة 19.
– نائب رئيس المحكمة الابتدائية : يتم تعيينه من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية بناءً على اقتراح من رئيس المحكمة الابتدائية، وذلك وفقًا للمادة 21 من القانون 106.13. ويمكن تعيين أكثر من نائب واحد لرئيس المحكمة الابتدائية حسب الحاجة التنظيمية ومتطلبات العمل، وذلك للقيام بالمهام القضائية والولائية التي يتولى رئيس المحكمة مسؤوليتها.
– القضاة : هم باقي القضاة المكلفين بالفصل في القضايا المعينة بالمحكمة الابتدائية.
– نائب أول لوكيل الملك : يتم تعيينه من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية بناءً على اقتراح من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، وذلك وفقًا للمادة 21 من القانون 106.13. كما يمكن تعيين نائب ثانٍ ونائب ثالث ونائب رابع، حسب ما تقتضيه الحاجة العملية ومتطلبات العمل.
– باقي نواب وكيل الملك : هم قضاة النيابة العامة في المحكمة الابتدائية الذين يتم تعيينهم في منصب نائب لوكيل الملك، ويضطلعون بالمهام القضائية المتعلقة بالنيابة العامة تحت إشراف وكيل الملك.
– رئيس كتابة الضبط : هو المسؤول الأول عن موظفي كتابة الضبط في كل محكمة، ويشغل هذا المنصب من خلال إشرافه المباشر على الموظفين الذين يعملون تحت إدارته. ويقوم بمراقبة تقييم أداء هؤلاء الموظفين وتنظيم أعمالهم، بالإضافة إلى تدبير الرخص المتعلقة بهم. كما يؤدي مهامه القضائية ضمن إطار سلطة ومراقبة رئيس المحكمة.
ويخضع في مهامه الإدارية والمالية لسلطة ومراقبة الوزير المكلف بالعدل، مع خضوعه لإشراف رئيس المحكمة. ويتم تعيينه من بين الأطر المحددة في المادة 19 من هذا القانون، وفقًا للشروط والإجراءات التي تحددها النصوص التنظيمية المعمول بها.
– رئيس كتابة النيابة العامة : هو المسؤول الأول عن موظفي كتابة النيابة العامة في كل محكمة، ويقوم بالإشراف المباشر على الموظفين التابعين له، بالإضافة إلى مراقبة تقييم أدائهم وتنظيم عملهم وتدبير الرخص الخاصة بهم. كما يؤدي مهامه القضائية تحت سلطة ومراقبة وكيل الملك.
ويخضع في مهامه الإدارية والمالية لسلطة ومراقبة الوزير المكلف بالعدل، بالإضافة إلى إشراف رئيس المحكمة. ويتم تعيينه من بين الأطر المحددة في المادة 19 من هذا القانون، وفقًا للشروط والإجراءات التي تحددها النصوص التنظيمية السارية.
– رؤساء المصالح وموظفو كتابة الضبط : هم المسؤولون عن المصالح التي تشكل كتابة الضبط، حيث يعمل بها موظفون ينتمون إلى هذه الهيئة.
– رؤساء المصالح وموظفو كتابة النيابة العامة : فهم المسؤولون عن المصالح التي تتكون منها كتابة النيابة العامة، ويعمل بها موظفون ينتمون إلى هذه الهيئة أيضًا.
ثانيا // تنظيم المحاكم الابتدائية :
وفقًا للمادة 43 من قانون التنظيم القضائي، تنقسم المحاكم الابتدائية إلى ثلاثة أنواع: الأولى هي المحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة، والثانية هي المحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة التي تشمل أقسامًا متخصصة في القضاء التجاري والإداري، أما النوع الثالث فيتمثل في المحاكم الابتدائية المصنفة التي يمكن إحداثها وفقًا لأحكام المادة 48 من نفس القانون.
وحسب المادة 42 من قانون التنظيم القضائي، التي حلت محل الفصل الثاني من ظهير 15 يوليوز 1974 المعدل بموجب الظهير الشريف رقم 1.93.205 الصادر في 10 شتنبر 1993، تتألف المحكمة الابتدائية من مجموعة من الأعضاء والمسؤولين، وهم: الرئيس، وكيل الملك، نائب أو أكثر للرئيس وقضاة، نائب أول أو أكثر لوكيل الملك وباقي نوابه، بالإضافة إلى رئيس كتابة الضبط، رئيس كتابة النيابة العامة، رؤساء المصالح، موظفي كتابة الضبط، وموظفي كتابة النيابة العامة.
يظهر من هذه المادة أن المشرع قد بذل جهودًا كبيرة لتجاوز الانتقادات التي كانت توجه للفصل الثاني من التنظيم القضائي لسنة 1974. من أبرز هذه الانتقادات كان الحديث عن “القضاة النواب” الذين كانوا يُعتبرون جزءًا من قضاة الأحكام، وهو ما كان مثارًا للجدل نظرًا لعدم وجود تمييز واضح بين القضاة والقضاة النواب في إطار التنظيم القضائي لعام 1974.
إضافة إلى الملاحظة المذكورة أعلاه، فإن المادة 42 من القانون جاءت بصياغة أكثر انسجامًا مع التطورات الكبيرة التي شهدتها منظومة العدالة. فقد أصبح النص الجديد يشير إلى “نائب أو أكثر للرئيس” و”نائب أول أو أكثر لوكيل الملك” عوض ما كان عليه الأمر سابقا.
أما باقي القضاة، فلا يتولون النيابة عن الرئيس، كما أن باقي نواب وكيل الملك لا يمكنهم تولي النيابة المباشرة عنه. ومن خلال ما نعتقده، يمكن القول إن هذا التحديد يسهم في تسهيل سير العمل داخل المحكمة، من خلال تحديد الجهة المخاطبة بشكل واضح في حال غياب الرئيس أو الوكيل أو في حالة تعذر قيامهما بمهامهما بسبب مانع معين. كما أن هذا التحديد يسهم في تحديد المسؤوليات على مستوى كل محكمة، مما يعزز من وضوح الهيكل التنظيمي لها.
ويمكن تقسيم هذه المحاكم بحسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها إلى عدة أقسام، تشمل: أقسام قضاة الأسرة، وغرف قضاء القرب، وغرف مختصة بالقضايا المدنية والتجارية والعقارية والاجتماعية والزجرية.
تنظر أقسام قضاء الأسرة في قضايا الأحوال الشخصية، مثل الطلاق والنفقة والحضانة، بالإضافة إلى قضايا الميراث، الحالة المدنية، شؤون التوثيق، القاصرين والكفالة، وكل ما يتعلق برعاية وحماية الأسرة بشكل عام.
أما غرف قضاء القرب، فتختص بالنظر في الدعاوى الشخصية والمنقولة التي لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف درهم، باستثناء النزاعات المتعلقة بمدونة الأسرة، القضايا العقارية، القضايا الاجتماعية، والإفراغات. كما تنظر غرف قضاء القرب أيضًا في المخالفات المنصوص عليها في القانون المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاتها.
ويمكن لكل غرفة من هذه الغرف أن تبحث وتحكم في جميع القضايا المعروضة أمام المحكمة، بغض النظر عن نوعها، باستثناء تلك التي تختص بها أقسام قضاء الأسرة. هذا التوزيع يعزز من كفاءة المحكمة ويسمح بتخصيص الجهود لمختلف أنواع القضايا وفقًا لاختصاصاتها المحددة.
فكما هو واضح من الفصل أعلاه، تتشكل المحاكم الابتدائية من جانبين رئيسيين: الأول يتعلق بالرئاسة، ويتكون من الرئيس والقضاة، أما الثاني فيتعلق بالنيابة العامة ويتكون من وكيل الملك ونوابه. إلى جانب هذين الجناحين، توجد كتابة الضبط التي تُعتبر المحرك الإداري للمحكمة، بالإضافة إلى كتابة النيابة العامة والمصالح الأخرى التي قد تُحدث داخل المحكمة.
يرتب القضاة والنواب في المحاكم الابتدائية، باستثناء الحالات التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك، في الدرجة الثالثة وفقًا للمواد 13 و 14 و 16 من النظام الأساسي للقضاة الصادر بتاريخ 24 مارس 2016. أما الرئيس ووكيل الملك في المحاكم الابتدائية، فيتم ترتيبهما كمبدأ عام في الدرجة الثانية على الأقل.
ويمكن تقسيم المحاكم الابتدائية بحسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها كما سبق ذكره إلى عدة أقسام، مثل: أقسام قضاء الأسرة، وأقسام قضاء القرب، وغرف مدنية، وغرف الأحوال الشخصية والميراث، وغرف عقارية، وغرف اجتماعية وزجرية. ومع ذلك، يمكن لكل غرفة أن تنظر في أي نزاع يعرض على المحكمة، بغض النظر عن نوع القضية أو ارتباطها المباشر بطبيعة القضايا التي تختص تلك الغرفة بالنظر فيها.
ومع ذلك، فإن التعديلين الجديدين اللذين أدخلهما المشرع على هذا الفصل بتاريخ 03 فبراير 2004 و 17 غشت 2011 وضعا استثناءً على المقتضيات السابقة، حيث تم منح الاختصاص لأقسام قضاء الأسرة وحدها، دون غيرها من الغرف المكونة للمحاكم الابتدائية، في كل ما يتعلق بشؤون الأسرة. يشمل ذلك القضايا الواردة في مدونة الأسرة، مثل الزواج، الطلاق، الأهلية، النيابة الشرعية، الوصايا والميراث، بالإضافة إلى القضايا الواردة في نصوص خاصة أخرى، مثل كفالة الأطفال المهملين، شؤون القاصرين، التوثيق، والحالة المدنية، وكل ما يتعلق باختصاص قضاء القرب.
وإذا كان التعديل الأول يهدف إلى حصر اختصاص قضايا الأسرة في أقسام قضاء الأسرة فقط، فإن العبارة الأخيرة الواردة في تعديل الفصل 2 من ظهير التنظيم القضائي لسنة 1974 تثير عدة تساؤلات، خاصة فيما يتعلق باختصاص هذه الأقسام في القضايا الجنائية المرتبطة بالأسرة.
يتجلى هذا التساؤل بشكل خاص في القضايا الجنائية مثل الخيانة الزوجية، العلاقات الجنسية غير المشروعة بين الأصول والفروع (المعروفة بزنا المحارم)، والجرائم التي يكون أطرافها أزواجًا أو آباءً أو أبناءً، بالإضافة إلى قضايا إهمال الأسرة. هذا يثير التساؤل حول مدى اختصاص أقسام قضاء الأسرة في التعامل مع مثل هذه القضايا الجنائية.
فهل يمكن اعتبار هذه القضايا ضمن اختصاص أقسام قضاء الأسرة، تفسيرًا لعبارة “بكل ما له علاقة بالأسرة”؟
في الواقع، رغم وجود النيابة العامة في أقسام قضاء الأسرة واعتبارها طرفًا أصليًا في قضايا الأسرة وفقًا للمادة الثالثة من مدونة الأسرة، فإن هذه الأقسام تستبعد النظر في القضايا الجنائية المتعلقة بالأسرة. وبالتالي، يبقى الاختصاص بالقضايا الجنائية منحصرًا في الغرف الجنحية بالمحاكم الابتدائية. ومن هنا، نعتقد أنه من الضروري إعادة النظر في هذه العبارة، إذ إنها تخلق نوعًا من اللبس. وحتى إذا كان من المفترض منح الاختصاص في القضايا الجنائية المرتبطة بالأسرة لأقسام قضاء الأسرة، فإن ذلك قد يشكل عبئًا إضافيًا عليها، خصوصًا في ظل الاكتظاظ الذي تشهده هذه الأقسام نتيجة كثرة القضايا المعروضة أمامها.
وقد بين المرسوم الصادر في 16 يوليوز 1974، تطبيقًا لظهير التنظيم القضائي الصادر في 15 يوليوز 1974، أن الجهة المختصة بتحديد عدد الغرف وتكوينها هي الجمعية العامة للمحكمة الابتدائية. وتتكون هذه الجمعية من جميع القضاة، سواء كانوا قضاة حكم أو قضاة نيابة عامة، بالإضافة إلى رئيس كتابة الضبط الذي يشارك في أشغال الجمعية المذكورة.
وتنعقد الجمعية العامة للمحكمة الابتدائية خلال الخمسة عشر يومًا الأولى من شهر دجنبر، أو كلما اعتبر الرئيس ذلك ضروريًا، للاضطلاع بالمهام المنوطة بها قانونًا. وتشمل هذه المهام تحديد عدد الغرف وتعيين القضاة الذين يشكلونها، بالإضافة إلى توزيع القضايا بين الغرف المختلفة، وتحديد أيام وساعات الجلسات بما يضمن انتظام سير العمل داخل المحكمة.
ويجب الإشارة إلى أن تكليف القضاة بتشكيل الغرف يثير بعض المشاكل، إذ في ظل الخصاص الذي تعاني منه المحاكم الابتدائية من حيث عدد القضاة، غالبًا ما يكون القاضي الواحد عضوًا في أكثر من غرفة. هذا الأمر قد يعقد أداءه لوظيفته، حيث تتراكم عليه الملفات المتعلقة بالغرف التي يشارك فيها، بالإضافة إلى ما يتطلبه عمله من إجراء الأبحاث والمهام المتعلقة بالقضايا والنزاعات. كما أنه يُلزم بتحرير الأحكام التي تُصدرها كل غرفة ينتمي إليها، مما يضيف عبئًا إضافيًا على عمله القضائي.
ومما يزيد من صعوبة الأمر أن يكون مجال تدخل الغرف متباعدًا، مثل أن يكون القاضي عضوًا في الغرفة المدنية، وفي الغرفة الجنحية، وفي قسم قضاء الأسرة. في هذه الحالة، يُلزم القاضي بالتخصص في مجالات قانونية متنوعة، ويتعين عليه متابعة المقتضيات التشريعية والاجتهادات المرتبطة بكل غرفة من الغرف التي عينته الجمعية العامة عضوًا فيها.
لذلك، ومن أجل التخفيف على القضاة من جهة وحماية لحقوق المتقاضين من جهة أخرى، من الضروري تزويد المحاكم بالعدد الكافي من القضاة. هذا يسمح لكل قاضٍ بالتركيز على الملفات المعروضة أمامه، مما يمكنه من دراسة كل قضية بشكل دقيق ومناقشة جميع جوانبها القانونية والواقعية.
شارك هذا المحتوى: