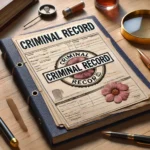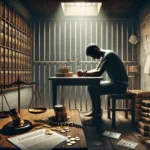تواصل معنا
نصت المادة السابعة من قانون المسطرة الجنائية ” إن حق إقامة الدعوى المدنية للتعويض عن الضرر الناتج عن جناية أو جنحة أو مخالفة، يرجع لكل من تعرض شخصيا الضرر جسماني أو مادي أو معنوي تسببت فيه الجريمة مباشرة.
يمكن للجمعيات المعلن أنها ذات منفعة عامة أن تنتصب طرفاً مدنياً، إذا كانت قد تأسست بصفة قانونية منذ أربع سنوات على الأقل قبل ارتكاب الفعل الجرمي، وذلك في حالة إقامة الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة أو الطرف المدني بشأن جريمة تمس مجال اهتمامها المنصوص عليه في قانونها الأساسي.
يمكن للدولة والجماعات المحلية أن تتقدم بصفتها طرفاً مدنياً لمطالبة مرتكب الجريمة بأن يرد لها المبالغ التي طلب منها دفعها للموظفين أو ذوي حقوقهم طبقاً للقانون الجاري به العمل”.
ونصت المادة التاسعة على أن ” هذه الدعوى يمكن أن تقدم أمام المحكمة الجنائية إلى جانب الدعوى العمومية في آن واحد”. والمقصود بالدعوى المدنية التابعة الطلب الذي يقدمه المتضرر أمام المحكمة الجنائية وهي تنظر في الدعوى العمومية، بهدف الحصول على تعويض للضرر الذي لحقه من الجريمة المعروضة عليها، وتخضع الدعوى المدنية التابعة لشروط حددها القانون وهي كذلك لها أطرافها وموضوعها وأسباب تنقضي بها.
أولا – طرفا الدعوى المدنية التابعة :
طرفا الدعوى المدنية هما المدعي والمدعى عليه، والمدعي هو من يطالب بتعويض عما لحقه من ضرر بسبب الجريمة. والمدعى عليه هو المتهم، مرتكب الجريمة أو المساهم أو المشارك فيها، وورثة هؤلاء أو المسؤولون عنهم مدنيا المطلوب منهم أداء التعويض.
1) المدعي في الدعوى المدنية التابعة :
المدعي في الدعوى المدنية التابعة هو المتضرر، وتنص المادة السابعة من ق.م. ج. أن حق الادعاء بالحق المدني يرجع لكل شخص تعرض لضرر جسماني أو مادي أو معنوي تسببت فيه الجريمة مباشرة.
وبمقتضى المادة الثانية من قانون المسطرة المدنية يجب أن يكون المدعي (المجني عليه) متوفراً على الشخصية القانونية وعلى أهلية التقاضي. كما تشترط المادة السابعة من نفس القانون أن يوجد ضرر، وأن يلحق الضرر المدعي شخصياً، وأن يكون ناجما عن الجريمة مباشرة. ونعرض فيما يلي لهذه الشروط على التوالي:
أ – الشخصية القانونية وأهلية التقاضي :
يجب لكي تتوفر الصفة للمدعي بالحقوق المدنية، أن يكون أهلا للتقاضي وفقا لما يقرره قانون الأحوال الشخصية الخاص به. والأهلية هي قابلية الشخص لأن يكون أهلا لتحمل الحقوق والالتزامات، وأن يمارس بنفسه هذه الحقوق وأن ينفذ بنفسه هذه الالتزامات. وتنعدم هذه الأهلية أو تنقص بصغر السن وبالخلل العقلي وبالسفه (المواد من 213 إلى 219 من مدونة الأسرة). وبالإدانة بعقوبة جنائية (المادتين 37 و 38 من القانون الجنائي).
فإذا كانت الأهلية كاملة، فإن التصرف الذي يجريه الشخص يعتبر جائزاً. وإذا كانت ناقصة كان التصرف قابلا للإبطال (المواد من 225 إلى 228 من مدونة الأسرة)، وإذا كانت معدومة كان التصرف باطلا (المادة 224 من مدونة الأسرة)، ويترتب على عدم توفر أهلية الأداء لشخص معين، عدم إمكان قيامه بمباشرة التصرف. ولذلك قرر القانون أن يباشرها عنه ومعه شخص آخر حتى تكتمل لديه هذه الأهلية. وهذا الشخص إما أن يكون وليا أو وصيا أو مقدماً أو قيما، وذلك حسب الأحوال (المواد من 229 إلى 276 من مدونة الأسرة).
فالمدعي سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتباريا ملزم بإثبات صفته وتوفره على الشخصية القانونية التي تخوله حق التقاضي. وهي من النظام العام تثيرها المحكمة تتلقائيا. ويعتبر الشخص كامل الأهلية متى بلغ سن الثامنة عشرة، ويعتبر من لم يبلغ هذه السن محجوراً للصغر وبعد ناقص الأهلية ولا يمكنه ممارسة حقوقه المدنية بما فيها حق التقاضي (المادة 209 من مدونة الأسرة).
ب – الضرر :
أجاز المشرع رفع الدعوى المدنية أمام المحاكم الزجرية لتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة استثناء عن القواعد العامة في الاختصاص. ولذلك لا ينبغي التوسع في مفهوم الضرر الذي يمكن المطالبة به أمام القضاء الزجري حتى لا يخرج عن الحكمة التي توخاها المشرع منه فلا يكفي مطلق الضرر الناجم عن الجريمة حتى تكون للمتضرر الصفة للمطالبة بالتعويض عنه وتقبل دعواه المدنية، وإنما يلزم أن تتوفر فيه شروط هي كونه شخصيا ومباشراً ومحققاً وناشئا عن الجريمة المرفوعة بها الدعوى العمومية.
– الضرر الشخصي :
جاءت المادة السابعة صريحة في التعبير أن الضرر الذي يمكن المطالبة به أمام القضاء الزجري هو الضرر الذي يصيب الطرف المدني شخصياً. وضحية الجريمة يشمل المجني عليه كمالك المال في جريمتي السرقة والنصب، ومن تعرض جسمه للإيذاء في جرائم الاعتداء بالضرب والجرح والذي يلحقه ضرر شخصي من الجريمة مباشرة، دون أن يكون مجنيا عليه فيها،
كالابن الذي يلحقه ضرر مادي بفقده مورد العيش بسبب وفاة والده في حادثة سير فتنتقل إليه بعد وفاته حقوقه في التعويض، ويحق له أن ينتصب طرفا مدنياً أمام المحكمة الجنائية التي تحاكم المتهم بالجريمة التي ألحقت الضرر بوالده.
– الضرر المباشر :
لا يكفي أن يكون الضرر شخصيا، بل يتعين أن يكون مباشرا. أي أن يكون المدعي قد تضرر مباشرة من الجريمة موضوع المتابعة. ويترتب عن ذلك أنه لا ينتصب طرفا مدنيا إلا ضحية الجريمة دون غيره ممن يكون قد لحقه ضرر غير مباشر منها. وأن ضحية الجريمة لا يعوض إلا عن الضرر الناشئ مباشرة عن الواقعة الجرمية المطروحة على المحكمة الزجرية دون غيره من الأضرار التي لحقته من وقائع أخرى ولو كانت هذه الوقائع مرتبطة بالجريمة موضوع المتابعة.
نستنتج من هذا أن قصد المشرع من “أن يكون المدعي قد تضرر من الجريمة مباشرة” هو أنه يجب أن يكون ضحية للجريمة، وأن يطلب التعويض عن الضرر الذي لحقه من هذه الجريمة فقط، لا عن الأضرار الأخرى غير المباشرة. وفي حالة ما إذا كان الموروث قد أقام قيد حياته الدعوى المدنية التابعة، ينتقل الحق في مواصلتها إلى ورثته.
وما يشترط توفره في المطالب بالحق المدني لقبول دعواه، هو أن يطلب التعويض عن الضرر الناتج عن الجريمة المعروضة على المحكمة الجنائية التي هي السبب في الضرر المطلوب عنه التعويض.
2) المدعى عليه في الدعوى المدنية :
تنص المادة الثامنة من قانون المسطرة الجنائية بأنه ” يمكن إقامة الدعوى المدنية ضد الفاعلين الأصليين أو المساهمين أو المشاركين في ارتكاب الجريمة، وضد ورثتهم أو الأشخاص المسؤولين مدنياً عنهم”.
وتختص المحكمة الزجرية التي تنظر في الدعوى العمومية بالبت في الدعوى المدنية التابعة سواء كان المسؤول عن الضرر شخصاً ذاتيا، أو شخصاً معنويا خاضعا للقانون المدني، ولا تختص بالبت في الدعوى التابعة إذا كان المسؤول عن الضرر شخصاً ذاتيا من أشخاص القانون العام إلا إذا تعلق الأمر بدعوى مسؤولية من أجل ضرر تسببت فيه وسيلة من وسائل النقل.
فالمدعى عليه في الدعوى المدنية، هو كل شخص طبيعي أو معنوي يلزمه القانون بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة سواء كان فاعلا أصلياً أو مساهما أو مشاركا في ارتكابها. كما تجوز إقامتها على ورثة مرتكب الجريمة، أو ضد الأشخاص المسؤولين عنه مدنيا ونبين فيما يلي من هو المتهم والوارث والمسؤول عن الحقوق المدنية.
أ – المتهم :
المتهم هو الشخص المتابع في الدعوى العمومية (بفتح الباء)، الذي ارتكب الجريمة بإتيانه فعلا أصليا يجعل منه فاعلا فيها أو مشاركا أو مساهما في ارتكابها. وتجوز مقاضاة المتهم الذي أقيمت في حقه الدعوى العمومية، من أجل مطالبته بالتعويضات المدنية، سواء كان شخصاً طبيعيا أو شخصاً معنويا مادام القانون الجنائي أجاز الحكم على الشخص الاعتباري بالعقوبات والتدابير المنصوص عليها في المادة 127 من القانون الجنائي.
وإذا كان المتهم المطلوب بالتعويض ناقص الأهلية بسبب صغر السن ( تقل سنه عن 18 سنة ) ، أو السفه، أو الإدانة بعقوبة جنائية، تعين إدخال نائبه القانوني – الذي يسند إليه القانون حماية مصالح ناقص الأهلية – في الدعوى. وعلى المحكمة أن تثير تلقائيا عدم توفر الأهلية في المدعى عليه، وبالتالي تصرح بعدم قبول الدعوى تطبيقا لمقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية.
ب – الوارث :
إذا توفي المدعى عليه في الدعوى المدنية التابعة. فما هو تأثير وفاته على حقوق المدعي، وعلى الإجراءات التي يباشرها للمطالبة أمام المحكمة الزجرية بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من الجريمة؟
إذا توفي المدعى عليه والدعويان معا الدعوى العمومية والدعوى المدنية التابعة قائمتين أمام المحكمة الزجرية، فإن الدعوى العمومية تسقط بموت المتهم، وتواصل إجراءات الدعوى المدنية في مواجهة الورثة طبقا للمادة 12 من قانون المسطرة الجنائية.
وإذا سقطت الدعوى العمومية بعد إقامتها، وقبل وفاة المتهم بأحد أسباب السقوط، كالتقادم أو العفو أو نسخ القانون الجنائي أو بصدور مقرر اكتسب قوة الشيء المقضي به، فإن إجراءات الدعوى المدنية تواصل وحدها في مواجهة الموروث بعد موته في شخص من يخلفه من الورثة بصفتهم مدعى عليهم، والذين يتعين إدخالهم في الدعوى.
ج – المسؤول عن الحقوق المدنية :
تقضي المادة 9 من ق م ج في فقرتها الثانية بأن المحكمة الزجرية تكون مختصة سواء كان المسؤول عن الضرر شخصا ذاتيا أو معنويا خاضعاً للقانون المدني. كما أنها تختص بالنظر في القضايا المنسوبة لأشخاص القانون العام في حالة ما إذا كانت دعوى المسؤولية ناتجة عن ضرر تسببت فيه وسيلة من وسائل النقل.
فالأصل أن الجريمة حينما ينسب ارتكابها إلى فرد معين فإنه يلزم بتعويض الضرر الناشئ عنها، وهذه نتيجة طبيعية لمسؤولية الشخص عن أفعاله الضارة. وفي الفقرة المذكورة الزم المشرع شخصا آخر – غير المتهم – بتعويض الضرر الناشئ عن ارتكاب الجريمة وهو المسؤول عن الحقوق المدنية، الذي يقصد به الأشخاص الذين يقرر القانون مسؤوليتهم عن تعويض الأضرار التي يتسبب فيها خطأ غيرهم، وهم مذكورون على سبيل الحصر في قانون الالتزامات والعقود، وهم الدولة والبلديات والمتبوعون وأصحاب الحرف والأقارب ومن يلتزم برقابة مختلي العقل.
وإذا كان المسؤول المدني من أشخاص القانون العام كالدولة والمرافق العامة المتمتعة بالشخصية القانونية أو الجماعات الحضرية أو القروية فلا تجوز مطالبته بالتعويض أمام المحكمة الزجرية إلا إذا كان المتهم قد ارتكب الجريمة بوسيلة من وسائل النقل كالسيارات والشاحنات والجرارات والدراجات النارية وغيرها من الآليات ذات المحرك، فمساءلة أشخاص القانون العام أمام القضاء الجنائي قاصرة على الحالة التي يكون فيها المتسبب في الضرر وسيلة للنقل، دون الحالة التي يكون فيها الضرر ناشئا عن خطأ مصلحي لأحد المستخدمين.
وتطبيقاً لذلك يجوز إدخال شخص القانون العام كمسؤول مدني أمام المحكمة الزجرية في الحالتين الآتيتين: إذا كان المتهم تابعاً ومستخدما لديه وتسبب في الضرر بوسيلة نقل تحت حراسة نفس الشخص المعنوي العام أيضا؛ وإذا تسببت في الضرر وسيلة للنقل تحت حراسة الشخص المعنوي العام، ولو كان يسوقها وقت الحادثة شخص أجنبي، مادام لم تنقل إليه الحراسة.
وقد يكون المسؤول المدني هو المؤمن (بكسر الميم) نتيجة لعقد التأمين الذي يربطه مع المتهم أو المتسبب في الضرر (المؤمن له). ومن الأمثلة التي تشيع فيها هذه الممارسة حوادث السير، فكلما كان المتهم مرتكب لحادث مؤمناً على مسؤوليته المدنية وجب على المتضرر أن يدخل في الدعوى المدنية التابعة شركة التأمين لتحل محل المؤمن له في أداء التعويض استناداً إلى عقد التأمين.
د – الوكيل القضائي :
يقضي الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية أنه ” كلما كانت الطلبات تستهدف التصريح بمديونية الدولة أو إدارة عمومية أو مكتب أو مؤسسة عمومية للدولة في قضية لا علاقة لها بالضرائب والأملاك المخزنية وجب إدخال العون القضائي في الدعوى وإلا كانت غير مقبولة” .
وتنص المادة الثالثة من قانون المسطرة الجنائية على تبليغ الوكيل القضائي للمملكة بإقامة الدعوى العمومية في حق قاض أو موظف عمومي أو عون أو مأمور للسلطة أو القوة العمومية.
وتنيط المادة 37 من قانون المسطرة الجنائية مهمة تبليغ الوكيل القضائي بالنيابة العامة التي ينبغي عليها كذلك أن تشعر الإدارة التي ينتمي إليها الموظف المتابع بينما تنيط المادة 95 هذا الالتزام بقاضي التحقيق، الذي عليه أن يشعر الوكيل القضائي بالدعوى التي يقيمها المطالب بالحق المدني أمامه، إذا كان الشخص المتابع قاض أو موظفاً عموميا أو عونا تابعاً للسلطة أو القوة العمومية، وظهر لقاضي التحقيق أن الدولة يمكن أن تتحمل المسؤولية المدنية من جراء أعمال تابعها.
وينتقل هذا الالتزام إلى المحكمة التي يتعين عليها وفقاً للمادة 351 من ق.م.ج أن تشعر الوكيل القضائي للمملكة وفقا لمقتضيات الفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية، كلما قدمت إليها مطالب مدنية ضد أحد القضاة أو الموظفين المشار إليهم، وتبين احتمال قيام مسؤولية الدولة عن أعمال تابعها.
فقانون المسطرة الجنائية وقانون المسطرة المدنية تعرضا لإدخال الوكيل القضائي للمملكة في الدعويين العمومية والمدنية. وإشعار الوكيل القضائي بالدعوى المقامة ضد قاض أو موظف عمومي أو عون تابع للسلطة أو القوة العمومية، يقصد به تمكين الوكيل القضائي من تقديم طلباته الهادفة إلى الدفاع عن المصالح المالية للدولة، من قبيل المطالبة باستبعاد المسؤولية المحتملة للدولة عن القاضي أو الموظف المتابع جنائيا، كلما أثيرت مسؤوليتها عنه بالنسبة للجريمة المطلوب عنها التعويض،
أو إذا أقيمت الدعوى من طرف الدولة أو الجماعات المحلية بصفتها طرفاً مدنياً لمطالبة مرتكب الجريمة بأن يرد لها المبالغ التي طلب منها دفعها لموظفين أو ذوي حقوقهم طبقا للقانون الجاري به العمل. فتبليغ إقامة الدعويين الجنائية والمدنية إلى الوكيل القضائي للمملكة إجراء واجب.
وإذا كان قانون المسطرة الجنائية الجديد قد أهمل الإشارة إلى الجزاء الذي يترتب عن عدم إشعار الوكيل القضائي خلافا لما كان عليه الأمر في القانون الذي وقع الغاؤه، والذي كان ينص صراحة على عدم قبول الدعوى العمومية في حالة عدم إشعار الوكيل القضائي، فإن الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية ينص صراحة على ترتيب هذا الأثر على الطلبات المدنية المقدمة إلى القضاء والتي تستهدف التصريح بمديونية الدولة أو إدارة عمومية أو مكتب أو مؤسسة عمومية للدولة في قضية لا علاقة لها بالضرائب والأملاك المخزنية، واعتبر الطلبات المذكورة التي تهمل إدخال العون القضائي في الدعوى غير مقبولة.
ثانيا – ممارسة الدعوى المدنية التابعة :
1) مباشرة الدعوى المدنية :
نصت المادة العاشرة من ق م ج أنه: ” يمكن إقامة الدعوى المدنية منفصلة عن الدعوى العمومية لدى المحكمة المدنية المختصة. غير أنه يجب أن توقف المحكمة المدنية البت في هذه الدعوى إلى أن يصدر حكم نهائي في الدعوى العمومية إذا كانت قد تمت إقامتها”.
وجاء في المادة 11 من ق م ج أنه: ” لا يجوز للطرف المتضرر الذي أقام دعواه لدى المحكمة المدنية المختصة، أن يقيمها لدى المحكمة الزجرية. غير أنه يجوز له ذلك إذا أحالت النيابة العامة الدعوى العمومية إلى المحكمة الزجرية، قبل أن تصدر المحكمة المدنية حكمها في الموضوع”.
يستفاد من هاتين المادتين أنه يمكن للمتضرر أن يقيم الدعوى المدنية منفصلة عن الدعوى العمومية أمام المحكمة المدنية المختصة، غير أنه إذا أقيمت الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية وأقيمت الدعوى العمومية أمام المحكمة الزجرية بشكل منفصل يجب على المحكمة المدنية إيقاف البت في الدعوى المدنية إلى أن يبت القضاء الزجري بحكم نهائي في الدعوى العمومية تفادياً لحدوث تضارب بين القرارين.
والمدعي بالحق المدني الذي يقيم دعواه أمام جهة الاختصاص الأصلية، وهي المحكمة المدنية، لا يجوز له أن يقيمها من جديد أمام المحكمة الزجرية. غير أنه إذا كان قد أقام دعواه المدنية قبل تحريك الدعوى العمومية، ثم أقيمت بعد ذلك الدعوى العمومية، فإن المادة 11 من ق م ج أجازت للمدعي المدني، قبل أن تصدر المحكمة المدنية حكمها في الموضوع، أن يتخلى عن دعواه أمام المحكمة المدنية، ويرفعها إلى المحكمة الزجرية، نظراً لأن الطريق الجنائي لم يكن مفتوحا أمامه وقت رفع الدعوى المدنية ولم تكن له حرية الاختيار في ذلك الوقت.
وتنازل الطرف المدني عن طلباته المقدمة للمحكمة الزجرية، لا يمنعه من تقديم نفس الطلبات من جديد أمام المحكمة المدنية لأنها هي الأصل (المادة 356 من ق م ج).
ومن جهة أخرى فإن المادة 12 من ق م ج نصت بأنه إذا كانت المحكمة الزجرية تنظر في الدعويين العمومية والمدنية معا، ووقع سبب من أسباب سقوط الدعوى العمومية المنصوص عليها في المادة 4 ق م ج، فإن الدعوى المدنية تبقى قائمة وخاضعة لاختصاص المحكمة الزجرية.
ويتحقق عرض الدعوى العمومية على المحكمة بتوجيه الاستدعاء للمتهم بالحضور أمام المحكمة الزجرية قبل حدوث سبب السقوط، أو بالكيفيات المشار إليها في المواد 47 و 73 و 74 و 384 و 419 و 461 من قانون المسطرة الجنائية. وأما الدعوى المدنية فيتم عرضها بتقديم مذكرة كتابية كما هو منصوص عليه في المواد 92 وما بعدها إلى 96 و 349 و 350 ق م ج، أو بالتصريح شفويا في الجلسة بالمطالبة بالحق المدني، وينذر المطالب بالحق المدني لأداء الرسم القضائي الجزافي (المادة 350 من ق م ج).
وإذا كانت الدعوى العمومية معروضة على المحكمة ثم قدمت إليها الدعوى المدنية، لكن بعد أن حدث سبب السقوط، فإن المحكمة تصرح بسقوط الدعوى العمومية وبعدم الاختصاص بالنسبة للطلبات المدنية.
2) موضوع الدعوى المدنية :
لما كان سبب الدعوى المدنية هو الجريمة التي ترتبت عنها أضرار للغير، فإنه من حق هذا الأخير أن يطالب بتعويضه عنها، وبإصلاح تلك الأضرار وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل ارتكاب الجريمة، والمطالبة كذلك بالمصروفات التي استلزمها حصوله على حقه. والمدعى عليه في الدعوى المدنية التابعة هو الذي يلتزم بالتعويض والأداء.
أ – التعويض :
يخضع التعويض المدني أمام المحكمة الجنائية لنفس الأحكام التي تطبق على التعويض في المسؤولية التقصيرية، المطالب به في إطار دعوى مدنية أصلية. وتقضي المادة 108 من القانون الجنائي أن ” التعويضات المدنية المحكوم بها يجب أن تحقق للمتضرر تعويضاً كاملا عن الضرر الشخصي الحال المحقق الذي أصابه مباشرة من الجريمة “.
وتحدد المحكمة مقدار التعويض على أساس جسامة الضرر الذي لحق المضرور من الجريمة. وتقدير التعويض أمر موضوعي بيد محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه. والمحكمة تقدره بعد مناقشتها لوقائع القضية والاقتناع بثبوتها في إطار سلطتها التقديرية وتفحصها لوسائل الإثبات وتأكدها من حقيقة الأضرار.
ب – الرد :
يقصد بالرد إرجاع الأشياء أو المبالغ أو الأمتعة المنقولة الموضوعة تحت يد العدالة إلى أصحاب الحق فيها، فهو بمثابة إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل وقوع الجريمة، وتجوز المطالبة بالرد من طرف الضحية أو حتى من طرف المتهم ويمكن للمحكمة أن تحكم برد الأشياء المحجوزة من تلقاء نفسها، أو برد ثمنها إذا كان قد تقرر بيعها خشية فسادها أو تلفها أو نتيجة تعذر الاحتفاظ بها.
ووفقا لقانون المسطرة الجنائية ، فإن رد الأشياء المحتفظ بها لدى العدالة كأدوات اقتناع، أو التي ضبطت أثناء البحث إلى أصحاب الحق فيها متى لم تكن لازمة لسير الدعوى أو خطيرة أو محلا للمصادرة ولا تثار منازعة جدية بشأن ملكيتها أو حيازتها، ممكن في مختلف مراحل القضية من طرف النيابة العامة (المادتان 40 و 49)، ومن طرف قاضي التحقيق ( المادتان142 و 216) ومن طرف المحكمة (المادة 366).
والفصل 106 من القانون الجنائي ينص على أن الرد هو إعادة الأشياء أو المبالغ أو الأمتعة المنقولة الموضوعة تحت يد العدالة إلى أصحاب الحق فيها. ويضيف قانون المسطرة الجنائية على ذلك أن رد هذه الأشياء يتم في مرحلة البحث والتحقيق ما لم تكن لازمة لسير الدعوى أو خطيرة أو قابلة للمصادرة. وتبيح المادة 366 من ق.م.ج للمحكمة إعادة هذا النوع من الأشياء لأصحابها إذا توفرت الضمانات الكافية لإثبات الحاجة إليها والحماية من خطرها.
كما أن قانون المسطرة الجنائية (المادتان 40 و 49 ) أجاز لوكيل الملك وللوكيل العام للملك كلما تعلق الأمر بانتزاع حيازة بعد تنفيذ حكم كل في حدود اختصاصه أن يأمر باتخاذ أي إجراء تحفظي يراه ملائماً لحماية الحيازة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، على أن يعرض هذا الأمر على المحكمة أو هيئة التحقيق التي رفعت إليها القضية أو سترفع إليها، لتأييده أو تعديله أو إلغائه.
ج – المصاريف :
يستلزم دخول المدعي المدني أمام المحكمة الجنائية للمطالبة بتعويض عن الأضرار التي لحقته من الجريمة، أداء رسوم ومصاريف قضائية، ومن الطبيعي أن يطالب باستردادها. وعلى المحكمة أن تحدد من يتحمل عبء تلك المصاريف. فالفصل 105 من القانون الجنائي يقضي بأن كل حكم بعقوبة أو تدبير وقائي، يجب أن يبت في الصوائر ومصاريف الدعوى طبق القواعد المنصوص عليها في الفصلين 349 و 350 من قانون المسطرة الجنائية.
ويجب أن يبت علاوة على ذلك، إذا اقتضى الحال في طلبات الرد والتعويضات المدنية. المسألة لا تخلو من فرضيات. الأولى، أن يحكم لفائدة المدعي بالحق المدني بكل طلباته والثانية، أن ترفض الطلبات كلها، والثالثة أن يحكم له ببعض الطلبات فقط.
– إذا قضى الحكم للمدعي بالحق المدني بكل طلباته: يلتزم المدعى عليه – المتهم و المسؤول المدني إن وجد – بمصاريف الدعوى بوصفه طرفا في الدعوى وخاسراً لها، وليس بوصفه مسؤولا عن الضرر اللاحق بالطرف المدني . وقد أكدت ذلك المادة 367 من ق.م.ج أن كل حكم صدر بإدانة المتهم أو بالحكم على المسؤول المدني يجب أن يحملهما المصاريف التي تدفع للخزينة. وأضافت أنه يمكن أيضا تحميل هذه المصاريف للمتهم الذي حكم بإعفائه أو للمسؤول المدني.
– إذا رفضت طلبات المدعي بالحق المدني: على أساس أنها غير مؤسسة، لا يلتزم بها المتهم أو المسؤول المدني أو الدولة، ويقع عبؤها على المدعي. غير أنه يمكن إعفاء المدعي بالحق المدني إذا كان حسن النية من أداء المصاريف.
– عندما يحكم للمدعى بالحق المدني ببعض طلباته فقط: تحدد المحكمة مبلغ المصاريف التي يجب أن يعفى منها المحكوم عليه. ويجوز تقدير هذه المصاريف على أساس نسبة تبين في الحكم. وقد تعرض قانون المسطرة الجنائية لموضوع المصاريف في المادة 216 من ق.م ج بالنسبة لقاضي التحقيق، وفي المواد 246 و 349 و 367 و 368 من ق.م.ج بالنسبة للمحكمة في حالات الحكم بالبراءة أو بعدم المتابعة، وفي حالة الإدانة.
ثالثا – التنازل عن الدعوى المدنية والتقادم :
تنتهي الدعوى المدنية بتنازل المطالب بالحق المدني عن مطالبه، كما تنتهي بالتقادم.
1) التنازل عن الدعوى :
يجوز للطرف المتضرر أن ينهي الدعوى المدنية التابعة سواء أمام المحكمة الزجرية أو أمام هيئة التحقيق، بالتخلي عنها أو التصالح بشأنها أو بالتنازل عنها، دون أن يترتب عن ذلك انقطاع سير الدعوى العمومية أو توقفها، إلا إذا كانت شكايته شرطاً ضروريا للمتابعة. ففي هذه الحالة تسقط الدعوى العمومية. وتنازل الطرف المدني عن دعواه لا يحول دون الحكم عليه بالصوائر المؤداة قبل تنازله، وإنما يعفيه فقط من المصاريف التي أداها بعد تنازله.
وإذا كان تنازل الطرف المدني عن طلبه لا يحول دون إقامة الدعوى المدنية بعد ذلك أمام المحكمة المدنية المختصة، فإنه يمنع عليه أن يرجع إلى إثارة الدعوى المدنية بعد تنازله النهائي عنها في نفس القضية بموضوعها وسببها وطرفيها (المادتين 355 356 من ق م ج).
وإذا كان الأمر يتعلق بمتابعة من أجل جنحة من الجنح المنصوص عليها في المادة 41 من هذا القانون، فإنه يمكن للمحكمة المعروضة عليها القضية بناء على ملتمس النيابة العامة في حالة تنازل الطرف المتضرر من الفعل الجرمي عن شكايته أن توقف سير إجراءات الدعوى العمومية ما لم تكن قد بثت فيها بحكم نهائي (المادة 372 من ق م ج ) .
و إيقاف سير الدعوى لا يعني سقوطها، وإنما يقصد به حفظ الملف مؤقتاً إلى أن تتقادم الدعوى العمومية أو تسقط بسبب آخر من أسباب السقوط، ما لم تتقدم النيابة العامة بطلب لمواصلة البت فيها نتيجة لأسباب تمس الدعوى العمومية نفسها.
2) التقادم :
تقضي المادة 14 من ق م ج بأن الدعوى المدنية تتقادم طبقا للقواعد المعمول بها في القانون المدني. وإذا تقادمت الدعوى العمومية فلا يمكن إقامة الدعوى المدنية إلا أمام المحكمة المدنية، فتقادم الدعوى المدنية يخضع لقواعد وأحكام قانون الالتزامات والعقود في مدته وفي أسباب توقفه وانقطاعه.
وأما دعاوى التعويض من جراء الجرم وشبه الجرم، فتتقادم بمضي خمس سنوات تبتدئ من الوقت الذي بلغ فيه إلى علم الطرف المتضرر الضرر ومن هو المسؤول عنه. وتتقادم في جميع الأحوال بمضي عشرين سنة تبتدئ من وقت حدوث الضرر . ولا تثير المحكمة تلقائياً تقادم الدعوى المدنية وإنما على صاحب المصلحة التمسك به.
شارك هذا المحتوى: