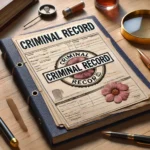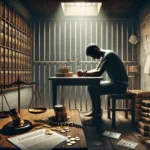تواصل معنا
أولا – التقادم في الدعوى العمومية :
ترمي فكرة التقادم إلى التسليم بسقوط الحق في المتابعة بسبب مرور الوقت وتفترض هذه النظرية أن المجتمع يكون قد تناسى الفعل الجرمي ولم يعد بحاجة لفتح جرح قد تعافى منه، وتحريك الدعوى العمومية عن فعل نسيه الضحايا والمجتمع ولم تعد لديهم مصلحة في إعادته للواجهة من جديد.
ويرى المجتمع أن ترك الدعوى العمومية في هذه الحالة خير من بعث النار الخامدة من الرماد، فكم سيدة كانت ضحية اغتصاب فر مغتصبها واختفى عن الأنظار مدة تزيد عن مدة تقادم الدعوى العمومية في الجنايات، تزوجت خلالها وأنجبت وقد تكون بعض بناتها أصبحن أمهات هن الأخريات، وقد لا يكون أزواجهن ولا أولادهن على علم بما تعرضت له منذ أكثر من خمسة عشر سنة، فإذا بالدعوى العمومية تعيد معاناتها إلى الواجهة وتنمي جروحها القديمة وتفتح جروحا جديدة لزوجها وأبنائهما وأحفادها.
وقد يتعلق التقادم بعقوبة لم تنفذ في إبانها واستطاع المحكوم عليه أن يظل بمنأى عن قبضة العدالة طيلة فترة من الزمان كافية لسقوطها هي مدة التقادم، يكون المجتمع بعدها قد نسي الجريمة والمحاكمة التي أنتجت عقوبتها ويكون المحكوم عليه قد عاش معاناة حقيقية من جراء هروبه و اختفائه حسنت سلوكه وأهلته للاندماج من جديد في وسطه الطبيعي، مما يجعل العقوبة تفقد معناها لنسيان المجتمع لظروف صدورها،
وهناك من يجد مبررات أخرى لفكرة التقادم مثل الحفاظ على حسن سير العدالة وقدسيتها، لأن قيام العدالة من سباتها بعد مدة (هي المدة المفترضة للتقادم) لمتابعة الجاني ومحاكمته أو لتنفيذ العقاب عليه يوحي بوجود خلل في سير العدالة التي تأخرت في القيام بواجبها، ويؤدي تهاون القائمين بها في تفعيل الإجراءات في الوقت المناسب إلى تكريس صورة سلبية عنها تفقدها ثقة المجتمع وتهز عرش قدسيتها الذي هو أساس اعتبار العدالة واحترامها في المجتمعات.
وهناك من يبرر فكرة التقادم بوجوب استقرار الأوضاع والمراكز في المجتمع ذلك أن أوضاع الناس تستقر بعد حين من الزمان، وأن تهديدهم بالدعاوي الزجرية باستمرار يجعل هذه الأوضاع غير مستقرة والاضطراب يضر بأحوال المجتمعات ويمنع تقدمها، ولذلك تقضي المصلحة الاجتماعية إنهاء الخصومات الجنائية في أسرع الأوقات.
وهناك من يعلل فكرة التقادم بضياع أدلة إثبات الجريمة، حيث تضيع بمرور الوقت ذاكرة الشهود أو يموتون أو ينتقلون إلى أماكن بعيدة، كما تندثر بعض أدوات الإثبات بمرور المدة، مما يبرر ترك الدعوى العمومية.
بالإضافة إلى ذلك، يرى بعض الفقه أن فلسفة التقادم تجد تبريرها في فكرة العقاب المعنوي والتكفير عن الجريمة، حيث يكون المجرم الهارب من ملاحقة العدالة في وضع نفسي سيئ، ويبقى طيلة فترة التقادم مطاردا بشبح الجريمة ويعتريه الخوف والقلق والاضطراب، مما يجعل هذه المعاناة النفسية كافية لمعاقبة الجاني الذي ظل مختفيا عن الأنظار طيلة الفترة المقررة للتقادم.
وإذا كانت هذه المبررات منتجة في تبرير الأخذ بفكرة التقادم، فإنها لم تسلم من انتقادات كبار الفقهاء، كسيزاري بيكاريا، وجيريمي بتنام، وكرارا الذين رأوا فيها تشجيعا على الإفلات من العقاب من جهة، وعدم الحد من خطورة المجرم الذي يظل حرا وغير مقيد، مما يجعل خطورته على المجتمع قائمة باستمراره بالإضافة إلى اتسام هذه الأفكار برومانسية قانونية تتجاهل الأوضاع النفسية المتباينة للمجرمين.
غير أن المشرع وإن كان قد سلم بسقوط الدعوى العمومية بالتقادم انسجاما مع فكرة نسيان الفعل أو نسيان الحكم من طرف المجتمع، فإنه وضع في الاعتبار حالات أوجد لهما آلية مناسبة للحيلولة دون سقوط الدعوى العمومية أو تقادم الحكم.
فقد نص المشرع في قانون المسطرة الجنائية على أسباب تقطع التقادم أو توقفه، وقطع التقادم هذا يتم بكل إجراء من إجراءات التحقيق أو من إجراءات المتابعة تقوم به السلطة القضائية أو تأمر به، ويؤدي إلى انطلاق أجل جديد للتقادم، مساو للمدة الأصلية ابتداء من تاريخ آخر إجراء انقطع به التقادم. وتوقف مدة التقادم يتأتى من استحالة إقامتها بسبب القانون نفسه، وفي هذه الحالة يتوقف احتساب أجل التقادم طيلة الفترة التي يكون فيها المانع القانوني قائها، وينطلق احتساب ما تبقى منها بزوال المانع.
وأما السبب الواقف فيتمثل في استحالة تحريك الدعوى العمومية الناتجة عن القانون نفسه، ولا يعني توقف التقادم إغفال احتساب المدة المنصرمة منذ تاريخ ارتكاب الفعل الجرمي، وإنما يعني أن حساب التقادم يتوقف في التاريخ الذي يطرأ فيه المانع القانوني الذي يحول دون إقامة الدعوى العمومية، ويستأنف السريان بزوال المانع، مع احتساب المدة السابقة عن التوقف.
ويعود التقادم إلى مجراء من جديد ابتداء من اليوم الذي تزول فيه الاستحالة لمدة تساوي ما بقي من آمده وقت توقفه بمعنى أن توقف التقادم تبقى معه المدة السابقة على التوقف قائمة وتبدأ فترة أخرى ليتحقق التقادم بجمع الفترتين معًا (الفقرة الخامسة من المادة 6).
والتقادم في نهاية المطاف يتوقف على تبني المشرع لأجال يفترض أنها كافية لنسيان الفعل أو الحكم فيقرر إهمال الدعوى العمومية أو التخلي عن تنفيذ العقوبة بمرورها، وهذه هي القاعدة الأصلية التي اقرها المشرع غير أنه في بعض الأحوال الاستثنائية قد لا يكون ذلك الأجل كافيا لتناسي الفعل أو الحكم، مما ينبغي معه تفعيل إجراءات قاطعة أو قد يكون القانون نفسه مانعا من تحريك الدعوى أو تنفيذ الحكم خلال مدة معينة، مما يتعين معه توقيف العد وعدم اعتبار هذه المدة في احتساب التقادم، لأن عدم تحريك الدعوى العمومية أو عدم تنفيذ الحكم يكون بسبب القانون لا لغياب إرادة المتابعة أو التنفيذ.
ولقد حدد المشرع المغربي بمقتضى المادة 5 من قانون المسطرة الجنائية مدد التقادم فيما يلي: ” تتقادم الدعوى العمومية، ما لم تنص قوانين خاصة على خلاف ذلك :
– بمرور عشرين سنة ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجناية.
– بمرور خمس سنوات ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجنحة.
– بمرور سنتين ميلاديتين كاملتين تبتدئات من يوم ارتكاب المخالفة.
غير أنه إذا كان الضحية قاصراً وتعرض لاعتداء جرمي ارتكبه في حقه أحد أصوله أو من له عليه رعاية أو كفالة أو سلطة، فإن أمد التقادم يبدأ في السريان من جديد لنفس المدة ابتداء من تاريخ بلوغ الضحية سن الرشد المدني”.
وتعتبر مدة التقادم تطبيقا للمادة 750 من الآجال الكاملة، لا تشمل اليوم الأول ولا اليوم الأخير ، أي أنه لا يحسب ضمن المدة يوم ارتكاب الجريمة ويوم القيام بإجراء المتابعة، وإذا كان اليوم الأخير يوم عطلة امتد الأجل إلى أول يوم عمل بعده.
وتعتبر أيام عطل جميع الأيام المصرح بأنها كذلك بمقتضى نص خاص وإذا كانت هذه الآجال المحددة بمقتضى المادة الخامسة من قانون المسطرة الجنائية هي القاعدة العامة التي يمكن اعتمادها في تقادم الدعوى العمومية، فإن ثمة استثناءات ترد على هذا الأصل بمدد قد تطول وقد تقصر في بعض القضايا النوعية التي تنظمتها قوانين خاصة.
وبديهي أن المشرع المغربي أخذ في المادة الخامسة من قانون المسطرة الجنائية بطبيعة الجريمة وحدد أجالا مختلفة لتقادم المخالفات والجنح والجنايات بحسب طبيعة الأفعال التي تتشكل منها الجريمة، ولذلك، فإن تطبيق القواعد القانونية المتعلقة بحالة العود أو ظروف التخفيف لا يؤثر على طبيعة الجريمة، فالجنحة لا تصبح جناية من جراء تطبيق أحكام العود مثلا.
كما أن الجناية لا تصبح جنحة من جراء إعمال ظروف التخفيف أو الأعذار القانونية، فهذه الظروف لا تغير الطبيعة القانونية للجريمة، وقد نص الفصل 112 من مجموعة القانون الجنائي على ذلك صراحة على أن “لا يتغير نوع الجريمة إذا حكم بعقوبة متعلقة بنوع أخر من أنواع الجرائم لسبب تخفيف أو لحالة عود” .
أنا ظروف التشديد، فإنها تغير طبيعة الفعل، حيث إن الجنحة تصبح جناية من وراء اقترانها بظروف التشديد إذا كانت العقوبة المقررة لها من جراء ارتباطها بظروف التشديد عقوبة جنائية، وقد نص الفصل 113 من مجموعة القانون الجنائي على ذلك: ” يتغير نوع الجريمة إذا نص القانون على عقوبة متعلقة بنوع آخر من أنواع الجرائم لسبب ظروف التشديد”.
ويبدأ أجل التقادم في الاحتساب من اليوم الموالي لارتكاب الفعل الجرمي، فإذا انصرم الأجل القانوني المحدد دون إقامة الدعوى العمومي من طرف النيابة العامة أو الجهة المخول لها ذلك تسقط هذه الدعوى بمضي مدة تقادمها، غير أن أمد تقادم الدعوى العمومية ينقطع بكل إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة تقوم به السلطة القضائية أو تأمر به، ويسري هذا الانقطاع كذلك بالنسبة للأشخاص الذين لم يشملهم إجراءات المتابعة أو التحقيق أو المحاكمة.
ويبدأ أجل جديد للتقادم في السريان ابتداء من أخر إجراء انقطع آمده وتكون مدته مساوية للمدة السالفة، وهذا ما كرسته المادة السادمة من قانون المسطرة الجنائية التي تنص صراحة على انقطاع أمد تقادم الدعوى العمومية بكل إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق أو المحاكمة تقوم به السلطة القضائية أو تأمر به، وبكل إجراء يعتبره القانون قاطعا للتقادم”.
وفي إطار الحماية التي أقرها القانون للقاصرين، نصت ف الأخيرة من المادة الخامسة من قانون المسطرة الجنائية، على وقف التقادم لمصلحة الضحية القاصر الذي تعرض لاعتداء جرمي ارتكبه في حقه أحد أصوله أو من له عليه رعاية أو كفالة أو سلطة، حيث تعد فترة قصور الصحية فترة توقف للتقادم بالنسبة للقاصر حتى يبلغ سن الرشد المدني، ولا يسري الأجل إلا ابتداء من تاريخ بلوغه 18 سنة شمسية كاملة.
ثانيا – التقادم في الدعوى المدنية :
تقضي المادة 14 من قانون المسطرة الجنائية بأن ” الدعوى المدنية تتقادم طبقاً للقواعد المعمول بها في القانون المدني. وإذا تقادمت الدعوى العمومية فلا يمكن إقامة الدعوى المدنية إلا أمام المحكمة المدنية”.
ومنه تحدد فترة تقادم الدعاوى المدنية الناشئة عن الجريمة طبقا لمقتضيات الفصل 106 من ق. ل.ع الذي ينص على ما يلي: ” إن دعوى التعويض من جراء جريمة أو شبه جريمة تتقادم بمضي خمس سنوات تبتدئ من الوقت الذي بلغ فيه إلى علم الفريق المتضرر الضرر ومن هو المسؤول عنه، وتتقادم في جميع الأحوال بمضي عشرين سنة تبتدئ من وقت حدوث الضرر”.
– وترتيبا عليه، يتبين أن لتقادم الدعوى المدنية الناجمة عن العمل غير المشروع من الجريمة مدتين، إحداهما قصيرة والأخرى طويلة. والمدة القصيرة، أمدها خمس سنوات تبتدئ من اليوم الموالي لليوم الذي يبلغ به إلى علم المتضرر الضرر ومن هو المسؤول عنه، وهكذا فالتقادم القصير يستلزم توافر شرطين، توافر العلم بحدوث الضرر، والعلم بالمسؤول عن الضرر.
وهكذا قد يتعرض شخص لجريمة تضر به دون أن يدرك ذلك، كأن ترتكب ضده سرقة فلا يعلم بها نهائيا أو يعلم بها ولكنه لا ينتبه لبعض المسروقات التي استولى عليها الجناة، ففي هذه الحالة يسري عليه تقادم الخمس سنوات بالنسبة للأضرار المتعددة التي ألحقتها به السرقة، إلا من يوم العلم بكل واحد منها على حدة.
كما لا يكفي العلم بحدوث الضرر لبدء سريان التقادم الخمسي، بل يتعين بالإضافة إلى ذلك أن يعلم المسؤول عن تعويض الضرر، وهذا الأجل تطبيق للقاعدة العامة في التقادم المنصوص عليها في الفصل 380 (الفقرة الخامسة) من ق. ل.ع والتي تقضي بأنه: ” لا يكون للتقادم محل إذا وجد الدائن بالفعل في ظروف تجعل من المستحيل عليه المطالبة بحقوقه خلال الأجل المقرر للتقادم”.
وعليه، فإن لم يعلم المتضرر بالمسؤول عن الضرر، فإن فترة التقادم القصير (الخمسي) هذه لا يحتج بها عليه من طرف محدث الضرر بالجريمة، حيث تظل فترة التقادم القصيرة متوقفة لصالح المتضرر الذي لا يتقادم الحق في الادعاء مدنيا بالتعويض إلا بمرور عشرين سنة من وقت حدوث الضرر.
أما المدة الطويلة أمدها عشرون سنة تبتدئ من اليوم الموالي ليوم حدوث الضرر الذي قد لا يصادف يوم وقوع الجريمة، وسواء بلغ إلى علم المتضرر حصول الضرر له أم لم يبلغ لأن القانون اعتد في هذه الصورة من صور التقادم بوقت حدوث الضرر الذي كان من الممكن المطالبة بتعويضه باستقلال تام عن تاريخ ارتكاب الجريمة أو العلم بالضرر ممن وقع عليه.
وهكذا يبتدئ تقادم الدعوى المدنية بالنسبة لمن أحرق ماله أو سرق منه من اليوم الموالي للإحراق أو السرقة لأنه اليوم الموالي لحدوث الضرر، سواء علم بهذه الجرائم أو لم يعلم، والذي يقع إيداؤه عدوانا ولا يظهر أثر هذا الاعتداء عليه (عاهة مستديمة مثلا) إلا بعد عشر سنوات يجعل تقادم الدعوى المدنية الناجمة عن هذا العدوان لا تبتدئ إلا من اليوم الموالي لظهور أثر الجريمة.
وعلى أي، فإن انصرام مدة التقادم، سواء كانت قصيرة أو طويلة إذا كانت تسقط الحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم مباشرة عن الجريمة (حتى ولو كانت الدعوى العمومية المقامة بسبب هذه الأخيرة ما تزال قائمة)، فإن السقوط ليس من النظام العام ولذلك فلا يثار تلقائيا من طرف المحكمة التي تفصل في المطالبة وإنما صاحب المصلحة في الاستفادة منه هو الذي عليه التمسك به، والمطالبة بإعماله، فإن هو فعل قضت المحكمة بسقوط الدعوى المدنية، وإن هو سكت عن ذلك امتنع عليها التصريح بقيامه ورفض الدعوى تبعا لذلك.
– ولا يكفي أن تتحقق الشروط المتعلقة ببداية مدة التقادم، وهي العلم بالضرر والمسؤول عنه، بل لابد من استمرار المدة دون أن يحصل سبب من أسباب التوقف أو القطع.
ويجب التمييز بين أسباب وقف التقادم وأسباب انقطاعه، فأسباب وقف التقادم هي تلك التي تعطل التقادم عن السير، حماية لبعض الأشخاص الذين يستحقون رعاية القانون، حيث إذا زال المانع عاد التقادم يمضي لسريانه مع احتساب المدة السابقة. أما أسباب قطع التقادم فإنها تقضي على المدة السابقة وتجعلها كأن لم تكن، حيث إذا ما بدأ سريان تقادم جديد بعد انقطاعه، وجب أن يستمر خلال المدة كاملة لتترتب عليه آثاره.
وقد تعرض المشرع الأسباب وقف التقادم في الفصول 378 و 379 و 380 من ق ل.ع وبالرجوع إلى هذه النصوص يتضح أن أسباب وقف التقادم ليست من طبيعة واحدة فبعضها يستمد من اعتبارات تتعلق بشخص الإنسان، وبعضها الآخر يرجع إلى ظروف مادية اضطرارية وهذه الأسباب التقادم التقادم لمصلحة الدائن الذي يكون مرتبطا بالمدين برابطة الزوجية أو البنوة، أو الأبوة، أو الأمومة، أو الولاية الشرعية، ووقف التقادم لمصلحة القاصر وناقص الأهلية، ووقف التقادم لمصلحة المفقود والغائب، ووقف التقادم لمصلحة الدائن الذي يقوم مانع يتعذر معه عليه أن يطالب بحقوقه أو لظروف مادية اضطرارية.
وقد جاء بهذا الخصوص في قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 2005/05/18 ما يلي: “يخضع التقادم لمقتضيات الفصل 378 من ق.ل.ع متى كانت العلاقة بين ناقص الأهلية ووصيه أو مقدمه، في حين يخضع لمقتضيات الفصل 379 من القانون المذكور إذا تعلق الأمر بعلاقة القاصر بواسطة مقدمه بالغير”.
وحدد المشرع أسباب قطع التقادم في كل من الفصل 381 و 382 من قانون الالتزامات والعقود وبالرجوع إلى هذه النصوص يتبين أن أسباب قطع التقادم إما أن تصدر عن الدائن وهو ما تعرض له المشرع في الفصل 381 من قانون الالتزامات والعقود، وإما أن تصدر عن المدين وذلك بإقراره بحق الدائن وهو ما تناوله المشرع في الفصل 382 من قانون الالتزامات والعقود.
وبالنسبة لأسباب قطع التقادم الصادرة عن الدائن فإنها على الشكل التالي: كل مطالبة قضائية أو غير قضائية يكون لها تاريخ ثابت ومن شأنها أن تجعل المدين في حالة مطل لتنفيذ التزامه، ولو رفعت أمام قاض غير مختص أو صرح بعدم قبولها لعيب في الشكل، وطلب قبول الدين في تفليسة المدين، وكل إجراء تحفظي أو تنفيذي يباشر على أموال المدين أو بكل طلب يقدم للحصول على الإذن في مباشرة هذه الإجراءات.
أما بالنسبة لأسباب قطع التقادم الصادر عن المدين، فهي: كل أمر يعرف المدين بمقتضاه بحق من بدأ التقادم يسري ضده، كما إذا جرى حساب عن الدين أو أدى المدين قسطا منه، وكان هذا الأداء ناتجا عن سند ثابت التاريخ أو طلب أجلا للوفاء أو قدم كفيلا أو أي ضمان آخر أو دفع بالتمسك بالمقاصة عند مطالبة الدائن له بالدين.
يمكن حصر الأسباب الأخرى التي قد تأتي لانقضاء الدعوى المدنية التابعة في أمرين: أولا ترك الدعوى المدنية التابعة وثانيا الحكم الحائز لقوة الشيء المقضي به.
شارك هذا المحتوى: